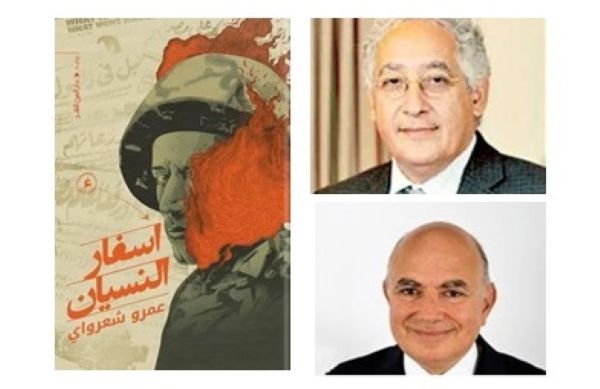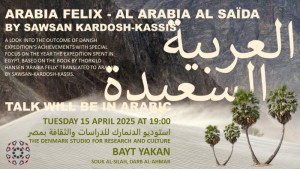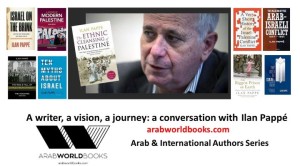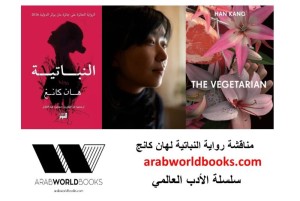لا شك أن ما بات يطلق عليه "الروايات التاريخية" قد اكتسبت على المستوى العالمي المزيد من الأرضية والانتشار على مدار العقود الأخيرة لما تلبيه من رغبة لدي قطاعات عريضة من القراء، خاصة من الشباب، للتعرف من خلال تلك الروايات على وقائع جرت في أزمنة ماضية وأحداث لفها الزمن بالنسيان أو الضياع، وذلك بالرغم من أن تلك الروايات هي المفترض أنها أعمال أدبية وأنها غير ملتزمة، ولا يمكن توجيه اللوم إليها إذا لم تلتزم، بوقائع التاريخ كما حدثت بحذافيرها أو بتفاصيلها.
إلا أن القراء سعوا، من خلال الإقبال على هذه النوعية من الروايات، إلى التعرف على ما يتطلعون إلى أن يكون "التاريخ الحقيقي"، حتى ولو كان من منظور المؤلف فقط أو طبقاً لانتماءاته الفكرية وانحيازاته التاريخية والمجتمعية، وذلك في سياق السعي المتزايد لمعرفة رؤى أخرى للتاريخ لا تكون متطابقة مع الروايات السائدة أو الغالبة أو تلك التي يتم تدريسها في المدارس والجامعة العامة والمعتمدة من قبل المؤسسات الرسمية للدول والحكومات.
وفي هذا السياق، وعلى سبيل المثال لا الحصر، حتى على صعيد المؤرخين على المستوى العالمي، ظهرت روايات بديلة للتاريخ مثل سلسلة "التاريخ الشعبي"، والتي ابتعدت عن التأريخ للحكومات والحكام وركزت على التأريخ لحركة المجتمعات وديناميتها. وعلى نفس النحو جذب اتجاه بعض الأدباء والروائيين إلى الروايات التي تتناول أحداث تاريخية وتطرح رؤى وتفسيرات غير مألوفة أعداداً متزايدة من القراء عبر العالم، خاصة من النشء والشباب.
وما سبق ذكره يصدق أكثر وأكثر في حالة المجتمعات العربية، التي غاب الاهتمام بالتاريخ كثيراً في صفوفها في الماضي ففقدت أجيال تلو أجيال الصلة بتاريخها وأصبحت منفصلة عن مراحل ومعالم عديدة وهامة من ذلك التاريخ بلا ذنب اقترفته. وبالتالي فإن هذه الشعوب، خاصة الشباب من أبنائها، يقبلون بنهم شديد على اقتناء وقراءة الروايات التاريخية بهدف التعرف على جوانب من تاريخهم البعيد أو القريب حتى ولو من زاوية واحدة فقط، هي زاوية رؤية الكاتب والأديب، والمجتمع المصري والشباب المصري ليسا استثناءًا من هذه القاعدة العامة.
ونتناول هنا رواية محكمة وشيقة في آن واحد للأستاذ الدكتور عمرو شعراوي الكاتب والأديب والأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهي بعنوان: "أسفار النسيان"، ومن إصدار دار العين للنشر، وصدرت طبعتها الأولى في عام 2022، ثم صدرت عدة طبعات متتالية لها بعد ذلك، وهي وإن لم تكن الرواية الأولى للكاتب، فإنها تمثل استمراراً لاهتمام وتركيز الكاتب على الرواية التاريخية وتميزه فيها على مدار رواياته السابقة، وفي مقدمتها "طوكر" و"ثورة قاو الكبرى".
وبداية، فإن الرواية، بالإضافة إلى كونها من الروايات التاريخية، فإنها من الروايات التي توظف حالة صحية معروفة طبياً، وبشكل أكثر تحديداً في مجال الطب العقلي والنفسي والعصبي، كإطار تدور في سياقه أحداث الرواية وفي ذات الوقت يستخدمها الكاتب كمبرر للغة السردية التي يعتمدها خلال معظم أجزاء الرواية، وهي لغة أعادت إلى الذاكرة اللغة التي استخدمها الكاتب والأديب الكبير صنع الله إبراهيم في روايته الشهيرة "67"، نتيجة تميز وفرادة كل منهما في لغتها السردية.
كما أن شخصيات الرواية تتسم بالتنوع، ليس فقط من جهة الفئة العمرية أو المستوى التعليمي أو الجنس أو طبيعة الوظيفة أو الخلفية الطبقية، ولكن أيضاً من جهة مواقف تلك الشخصيات تجاه ما شهده المجتمع المصري خلال الفترة التاريخية الهامة التي تتناول أحداثها الرواية وانعكاس تلك المواقف على التطورات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي كرت بها تلك الشخصيات وعلى أنماط العلاقات والتفاعلات فيما بينها.
وتقودنا الفقرة السابقة إلى تناول دلالات وأهمية اختيار المرحلة التاريخية التي تتناولها الرواية، وهي تلك التي تمتد على مدار عقد كامل، وتحديداً تقع ما بين الهزيمة في حرب يونيو 1967 وانتفاضة 18 و19 يناير 1977، وهو عقد شديد الثراء والعمق والتنوع في أحداثه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ليس فقط على الصعيد المصري ولكن أيضاً على الصعيد الإقليمي العربي والشرق أوسطي، بل وعلى الصعيد العالمي ككل.
ولقد بدأت تلك الفترة التاريخية بصدمة واجهت قطاعات واسعة من الشعب المصري تمثلت في هزيمة يونيو 1967 والتي نتج عنها احتلال إسرائيل لشبه جزيرة سيناء، ضمن أراض عربية أخرى شملت أيضاً هضبة الجولان السورية والضفة الغربية لنهر الأردن، بما في ذلك القدس الشرقية، وذلك بالرغم من سقف التوقعات المرتفعة للغاية التي سادت في المجتمع المصري قبل اندلاع الحرب في يوم الخامس من يونيو 1967، وهي توقعات لعب الإعلام المصري الرسمي والوحيد في ذلك الوقت دوراً كبيراً في رفعها إلى عنان السماء، وهو أمر تتناوله الرواية عبر الحوارات فيما بين شخصياتها وعبر عرض واقعي للتأثير شديد السلبية لانهيار تلك التوقعات لدي من كانوا في سن النشء والشباب بشكل خاص، والذين انهارت في لحظات أحلامهم التي كانت بدورها خليطاً من الأحلام والطموحات الشخصية وتلك المتعلقة بتصورهم للوطن الذي ينتمون إليه والمجتمع الجديد الذين يصبون إلى استكمال بنائه.
وحتى يكون الفهم أوضح لطبيعة تأثير هزيمة 5 يونيو 1967 على الأجيال المصرية الشابة في ذلك الحين فإن الرواية التي نعرض لها هنا، ومن خلال العديد من شخصياتها، كما يتبدى من خلال التعبير عن أفكارها وأقوالها، تبرز أن ما حدث لم يكن مجرد هزيمة عسكرية في معركة أو في حرب بل إن الأمر ذهب أبعد من ذلك في تأثيره وانعكاساته، فقد كانت هزيمة لنموذج بدا في حينه شبه متكامل وكان في طور التكوين والتشكيل والتطوير ما بين قيام ثورة 23 يوليو 1952 وهزيمة 5 يونيو 1967، حيث كان لهذا النموذج جوانبه وأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما كان له مكوناته المتصلة بالداخل المصري من جهة وتلك المرتبطة بالبيئات الإقليمية المحيطة بمصر ومجتمعها من جهة ثانية وكذلك ما يتعلق بالسياق العالمي الذي كانت مصر تنشط وتتحرك في إطاره من جهة ثالثة.
وكان الحدث الثاني الذي تلى هزيمة يونيو 1967 والذي احتل أهمية في سياق الرواية والتفاعل فيما بين شخصياتها وهو بدوره يرتبط بالهزيمة وناتج عنها، كما أنه كان من أهم الأحداث التي واجهتها مصر خلال العقد محل التناول في رواية "أسفار النسيان" للكاتب والأديب والروائي والأستاذ الجامعي والمثقف المتميز الدكتور عمرو شعراوي، وأقصد هنا التظاهرات الشعبية، والتي بدأت بالطلاب وامتدت إلى قطاعات أخرى مثل العمال والموظفين وغيرهم، والتي جرت في أعقاب الأحكام التي صدرت بحق عدد من كبار المسئولين العسكريين المتهمين بالتسبب في هزيمة 5 يونيو 1967، والتي عرفت تاريخياً وإعلامياً بـ "أحكام الطيران"، وهي تظاهرات جرت في شهري فبراير ومارس من عام 1968، ثم تكررت بأشكال متنوعة ولأسباب بعضها متشابه وبعضها مختلف في شهر نوفمبر من نفس العام، والتي كان لها أكثر من دلالة.
أما الدلالة الأولى لتلك التظاهرات، فقد كانت أنها جرت في سياق عالمي أوسع، فعام 1968 هو العام الذي شهد مظاهرات احتجاجية للشباب بشكل عام، وللطلاب بشكل خاص، في مناطق مختلفة من العالم، ربما كان الأبرز فيها هو ما حدث في فرنسا في ذلك العام و أدى في نهاية المطاف إلى استقالة الرئيس الفرنسي الجنرال / شارل ديجول، رئيس الجمهورية التاريخي لموطن الثورة الأم في تاريخ العالم الحديث ومؤسس الجمهورية الخامسة في تاريخ فرنسا في عام 1958.
وأما الدلالة الثانية لتظاهرات الشباب في مصر عام 1968، وكجزء من سياق أوسع لحراك الشباب على الصعيد العالمي، فقد كانت أن ذلك العام شهد الغزو السوفيتي لتشيكوسلوفاكيا آنذاك لقمع حركة تحررية هدفت لخروج تشيكوسلوفاكيا من دائرة النفوذ السوفيتي، وهو الأمر الذي دفع إلى الواجهة بتبلور تيار شعبي عريض وواسع، ارتكز أساساً على الشباب، مناهض لذلك الغزو، وانطلق من هناك إلى تبني أطروحة فكرية جديدة تمثلت فيما أطلق عليه آنذاك "اليسار الجديد"، وهي أطروحة ام تنشأ آنذاك بل نشأت ما بين صفوف بعض دوائر اليسار في العديد من بلدان أوروبا الغربية على مدار الفترة ما بين انتهاء الحرب العالمية الثانية في عام 1945 ومروراً بعقدي الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين من خلال ما يعرف بـ "مدرسة فرانكفورت" وما ارتبط بها من أسماء وقامات كبيرة مثل لوي التويسير وهربرت ماركوز.
إلا أن تلك الأطروحة، أي اليسار الجديد، ظلت أساساً مقصورة على فئات محدودة نسبياً من المثقفين والمفكرين والكتاب حتى جاءت انتفاضات الشباب في فرنسا وغيرها من بلدان العالم في عام 1968 لتحولها إلى أطروحة فكرية لها قواعد جماهيرية واسعة، خاصة في صفوف الشباب، والتي تبنت رؤى نقدية، اتسمت بالحدة في العديد من الأحيان، تجاه التفسيرات السائدة آنذاك للماركسية، وبشكل أكثر تحديداً للستالينية، ومن ثم ليس فقط تجاه الاتحاد السوفيتي بل وتجاه الأحزاب الشيوعية التقليدية في بلدان غرب أوروبا.
وترتبط الدلالة الثالثة بالعلاقة ما بين المشهد العالمي والمشهد المصري بالنسبة لحراك الشباب في عام 1968، ففي الحالة المصرية، فإن تظاهرات 1968 للشباب، خاصة الطلاب، كانت بلا شك ذات توجه يساري واضح، ولكنه لم يكن اليسار التقليدي المعروف لمؤسسات الدولة المصرية آنذاك، بل كان يسار من نوع جديد ومختلف عما رأيناه من قبل على ساحة النشاط الفكري والعمل السياسي في مصر، ولم يخل من تأثيرات "اليسار الجديد" الذي ظهر وبرز في ذلك العام في فرنسا ومناطق أخرى من أوروبا في بعض المجالات ولكنه اختلف مع الظاهرة العالمية الأعم في مجالات أخرى، فعلى سبيل المثال لا الحصر كانت الدعوة إلى ضرورة الجمع بين تحقيق الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاجتماعية كحتمية ضرورية وكضمانة وحيدة للحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي تحققت على صعيد معركة العدالة الاجتماعية من عام 1952 إلى عام 1967، وكان هذا من تأثير تحولات "اليسار الجديد" على الصعيد العالمي من الاقتصار على معالجة المسألة الاجتماعية / الاقتصادية إلى الجمع بينها وبين المسألة السياسية.
وعلى جانب آخر، كانت دعوة تظاهرات الشباب في مصر إلى حرب تحرير شعبية لتحرير شبه جزيرة سيناء من الاحتلال الإسرائيلي متأثرة بدرجة كبيرة بأدبيات وتجارب يسارية في بلدان من العالم الثالث مثل تجربة الحزب الشيوعي الصيني بزعامة "ماو زي دونج" التي انتهت بدخول الشيوعيين الصينيين العاصمة "بيجين" وإعلان قيام جمهورية الصين الشعبية في الأول من شهر أكتوبر من عام 1949، وتجربة دخول الثوار الكوبيين بزعامة فيديل كاسترو وأرنستو تشي جيفارا العاصمة الكوبية هافانا وإنهاء حكم الديكتاتور "باتيستا" في الأول من يناير 1959، وذلك بالإضافة إلى استلهام ما كان يجري آنذاك من نضال ثوار "الفييت كونج" فيما كان يعرف آنذاك بفيتنام الجنوبية، وكذلك التأثر بأدبيات فرانز فانون وغيره من مفكرين انتموا للعالم الثالث فيما يتعلق بحروب التحرير الشعبية وحروب العصابات وما شابهها.
وعلى جانب ثالث، فإن خصوصية حراك الشباب المصري في بدايات عام 1968 كانت تكمن في العامل الذي فجر تظاهرات فبراير 1968 وهو الأحكام التي وصفها المتظاهرون بالهزيلة والتي صدرت بحق المسئولين العسكريين الكبار المتهمين بالتسبب في هزيمة 5 يونيو من عام 1967، وهي رؤية قبلها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في ذلك الوقت وتماشى مع مطالب المظاهرات الشعبية عندما قرر إعادة المحاكمات حيث نتج عن إعادة المحاكمات أمام محاكم مختلفة، وإن كانت ذات طابع سياسي أيضاً، صدور أحكام أشد بكثير من الأحكام الأولى التي احتجت عليها مظاهرات فبراير ومارس 1968 الشعبية، وعلى ذات النمط سار تجاوب القيادة السياسية المصرية آنذاك مع المطالب الواسعة خلال التظاهرات بإقامة نظام سياسي ديمقراطي حقيقي يضمن المشاركة الشعبية الحقيقية ويحمي المكتسبات ذات الطابع التقدمي التي تحققت على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي منذ ثورة 23 يوليو 1952، ومن ثم أعلن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بيان 30 مارس 1968 كاستجابة، ولو جزئية، لتلك المطالب الشعبية العريضة، والذي وعد فيه الرئيس الراحل عبد الناصر بإدخال إصلاحات ديمقراطية جذرية، ولكن في إطار التنظيم السياسي الوحيد القائم في مصر في ذلك الوقت وهو الاتحاد الاشتراكي العربي، مع حديث الرئيس الراحل عبد الناصر في بعض اجتماعات اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي، الهيئة الأهم في إطار اتخاذ القرار في سياق التنظيم الشعبي والسياسي الوحيد في مصر في ذلك الوقت، عن نيته إعادة التعددية الحزبية لمصر في أعقاب تحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي وإزالة آثار عدوان 1967، وهي وعود جاءت أقل من سقف المطالب الشعبية، خاصة بين صفوف الشباب، وفي مقدمتهم الطلاب، في تلك الفترة التاريخية الهامة من تاريخ مصر المعاصر.
وإذا انتقلنا إلى الدلالة الرابعة لتظاهرات الشباب، خاصة الطلاب، في مصر والتي جرت على مدار شهري فبراير ومارس من عام 1968، والتي تجددت، وإن بأشكال وصور ومضامين مختلفة، في شهر نوفمبر من نفس العام، والتي احتلت مساحة لا بأس بها ضمن محور تفاعلات عدد من شخصيات رواية "أسفار النسيان" للروائي والكاتب والأديب والأستاذ الجامعي الدكتور عمرو شعراوي، نجد أنها تمثلت في أنها كانت المرة الأولى التي يلجأ فيها قطاع من اليسار المصري، وتحديداً المنتمين إلى "اليسار الجديد"، بحسب التعريف المصري لهذا المفهوم والذي عرضنا له فيما سبق، إلى النزول إلى الشارع احتجاجاً على سياسات وقرارات وتوجهات للسلطة الناصرية، وذلك للمرة الأولى منذ مظاهرات مارس 1954 خلال المواجهة بين كل من الرئيس الراحل محمد نجيب ومن وقف معه من أعضاء مجلس قيادة الثورة، والرئيس الراحل جمال عبد الناصر ومن اصطف معه من أعضاء المجلس، وذلك أيضاً بالرغم من سياسات وصفها عدد لا بأس به من رموز اليسار المصري آنذاك بانها تقدمية، وكذلك بالرغم من إعلان الحزب الشيوعي المصري حل نفسه في عام 1964 ودعوة أعضائه للانضمام إلى الاتحاد الاشتراكي العربي، تنظيم ثورة يوليو آنذاك، وأيضاً بالرغم من تبوأ عدد لا بأس به من الشخصيات اليسارية المصرية مناصب رفيعة، سواء في التنظيم السياسي الوحيد أو في وسائل الإعلام والصحف والدوريات المختلفة، وأخيراً بالرغم من علاقات التقارب بين السلطة الناصرية والاتحاد السوفيتي السابق الذي كان يقود في ذلك الوقت معظم العالم الشيوعي، باستثناء الصين تحت زعامة "ماو زي دونج" ومن سار على نهجها، وكذلك يوغوسلافيا تحت زعامة "جوزيب بروز تيتو" وألبانيا تحت زعامة "أنور خوجة".
أما الدلالة الخامسة والأخيرة التي سوف نتناولها هنا لتظاهرات 1968 في مصر فهي ملاحظة أن القطاع الأعظم من المشاركين في مظاهرات 1968 من الشباب، خاصة من الطلاب، هم من يمكن أن نطلق عليهم تعبير "أبناء ثورة يوليو" أو "أجيال ثورة يوليو"، أي الذين إما ولدوا بعد الثورة أو بدأ وعيهم يتبلور بعد 23 يوليو 1952، ولذا كان تظاهرهم ضد قيادة تلك الثورة بمثابة الصدمة للقيادة الناصرية والنخبة السياسية الموجودة في مصر في ذلك الوقت، حيث كان من الصعب أن يتم اتهامهم بأنهم متعاطفون مع القوى السياسية التي كانت تقود المشهد السياسي في مصر قبل 23 يوليو 1952، مثل حزب الوفد أو غيره من أحزاب وقوى، لانهم لم يكونوا في سن يسمح لهم بمعرفة تلك القوى والأحزاب، كما كانت الصدمة نتيجة أن هؤلاء الشباب والطلاب هم من أكثر من استفاد من عدد من إنجازات ثورة يوليو على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في مجال إتاحة التعليم المجاني على كافة مستويات التعليم المدرسي والجامعي وما هو فوق الجامعي لجميع النشء والشباب المصري وفي سياق إتاحة فرص العمل في فترة ما بعد التخرج من الجامعة من خلال ما كان يسمى آنذاك بـالتوظيف من خلال مكاتب القوى العاملة.
وتلى كلاً من حرب يونيو 1967 ومظاهرات 1968 حدث آخر لا يقل أهمية في تاريخ مصر المعاصر وتعكسه أحداث رواية "أسفار النسيان" للروائي والأديب والكاتب الكبير الأستاذ الدكتور عمرو شعراوي، وهو حرب الاستنزاف التي بدأتها مصر مبكراً بعد هزيمة يونيو 1967 بدايةً بمعركة رأس العش في الأول من يوليو 1967، وإغراق المدمرة البحرية الإسرائيلية "إيلات" في 21 أكتوبر 1967، واستمرت حتى دخول الولايات المتحدة الأمريكية على خط الوساطة بين مصر وإسرائيل وإعلان كل من الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر وملك الأردن الراحل الحسين بن طلال قبول مبادرة "روجرز" الأمريكية، والمسماة على اسم وزير الخارجية الأمريكي آنذاك "ويليام روجرز"، لوقف إطلاق النار وذلك في 7 أغسطس 1970.
وقد منحت تلك الحرب شعاع أمل للشعب المصري، خاصة قطاعات الشباب منه، وفي مقدمتهم الطلاب، بأن هناك أمل في إعادة البناء، ليس فقط للقوات المسلحة، بل للدولة ومؤسساتها بالكامل وعلى أسس جديدة تتلافى أخطاء ما قبل 1967 والتي أودت بمصر إلى هزيمة 5 يونيو 1967، وصولاً إلى تحرير الأراضي المحتلة واستعادة الكرامة الوطنية، وعلى جانب آخر، فإن هناك من بقي متأثراً بشكل كبير وفي اتجاه سلبي بهزيمة 1967 وبالتالي بقي متشككاً في إمكانية حدوث أي تحرك في اتجاه تحرير شبه جزيرة سيناء واستعادتها من الاحتلال الإسرائيلي أو في إعادة بناء الدولة ومؤسساتها، وعلى جانب ثالث، فإن هناك جزء ثالث من المواطنين، بمن في ذلك بعض الشباب، ممن انصرفوا عن الشأن والهم العام كلية وقاموا بالتركيز على مصالحهم الخاصة، وكيفية تعظيم ثرواتهم أيا كان مصدر تلك الثروات، وسواء كان ذلك بطرق شرعية أو غير شرعية، وحتى ولو كان ذلك الإثراء على حساب الوطن ومصالحه.
وعلى جانب رابع، فإن هناك قطاعاً آخر من المواطنين، وخاصة من الشباب، بمن فيهم الطلاب، كان رد فعله على هزيمة 5 يونيو 1967 التوجه نحو أشكال مختلفة من التدين، ليس بالضرورة التدين المسيس، ولكن مما أخذ صوراً متنوعة مما يعرف في علم الاجتماع بالتدين الشكلي أو التركيز على التجليات الشعائرية للأديان، وارتبط ذلك في بعض الحالات بخروج أسر مصرية بالكامل أو بعض أعضائها من مصر والتوجه في غالبية الحالات إلى بلدان في شبه الجزيرة العربية وبعض بلدان منطقة الخليج والتأثر بالثقافات الاجتماعية والتفسيرات الدينية السائدة في تلك المجتمعات على مدار الحقبة التاريخية التي تتناولها الرواية محل العرض والتحليل هنا، وما أودى به ذلك من استيراد هذه الأنماط من التفسيرات الدينية إلى داخل المجتمع المصري، والذي كان يعاني من شعور بالهزيمة للنموذج الذي جسدته قيادته السياسية نتيجة للهزيمة في حرب 1967.
وقد نجح الأستاذ الدكتور عمرو شعراوي في روايته "أسفار النسيان" في عرض وتفسير سلوكيات مختلف أطياف كل من الأنماط الأربعة من الشخصيات في المجتمع المصري التي اشرنا إليه فيما سبق من خلال شخصيات روايته، سواء الرئيسية والمركزية أو الثانوية والهامشية، سواء من خلال عرض أفكارها وأقوالها أو من خلال تحليل التفاعلات فيما بين تلك الشخصيات، أياً كان اتجاه تلك التفاعلات، تعاونية كانت أو صراعية أو تفاعلات تدور في إطار القدرة على إدارة مواطن الاتفاق والاختلاف ما بين شخصيتين أو أكثر من شخصيات الرواية، وأستطيع القول أن الكاتب قد تميز وأجاد بدرجة متميزة في هذا العرض والتحليل اللذين اتصفا بالعمق والسلاسة في ذات الوقت، كما أنه برز في صياغة وتطوير الحبكة الروائية على مدار أحداث الرواية المتصاعدة على نحو تراكمي. كما أن الكاتب قد برع في تطوير تلك التفاعلات، بما بدا أحياناً أنه تطور متدرج ومنطقي ومعتدل وبدا في أحيان أخرى ولو كان تغييراً فجائياً أو غير متوقع في ضوء الأحداث والتفاعلات السابقة في سياق الرواية.
أما الحدث العام الرابع الذي تشمله فترة رواية "أوراق النسيان" للأديب والكاتب الكبير الدكتور عمرو شعراوي فهو وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 28 سبتمبر 1970، والذي الحدث الذي كان بمثابة الصدمة، أو حتى الزلزال، للكثير من المصريين لأسباب متعددة.
وكمن السبب الأول في أن هناك من المصريين، بما في ذلك الشباب، من كان يرى أن الرئيس الراحل عبد الناصر هو الأمل الوحيد في الخروج من الدائرة المفرغة التي دخلت فيها مصر بحدوث هزيمة 5 يونيو 1967، حيث أن هؤلاء راهنوا على العديد من التحولات الإيجابية، من وجهة نظرهم، التي شهدتها الفترة المنقضية ما بين هزيمة يونيو 1967 ووفاة الرئيس الراحل في سبتمبر 1970، مثل إعادة بناء القوات المسلحة على أسس علمية وسليمة، وبدء اللجوء إلى تفعيل دور مراكز البحوث العلمية مثل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمركز القومي للبحوث ومركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وغيرها، وكذلك اعتدال السياسة الخارجية المصرية، خاصة فتح قنوات مع البلدان الغربية وإجراء مصالحات مع البلدان العربية المحافظة التي كانت مصر الناصرية في حالة تنازع، بل وحالة حرب، معها من خلال الصراع آنذاك في اليمن الشمالية وغيره لسنوات، بالإضافة إلى صدور بيان 30 مارس 1968 ووعود الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بإدخال إصلاحات سياسية وديمقراطية داخلية.
أما السبب الثاني لشعور قطاعات أخرى من الشعب المصري بالصدمة من وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فقد تمثل في شعور بعض المصريين، ومن بينهم بعض الشباب أيضاً، بأنه باعتبار أنهم حملوا الرئيس الراحل المسئولية الأساسية عن هزيمة يونيو 1967 ورفضهم قصر تحميل المسئولية عن تلك الهزيمة على القيادة العسكرية قبل الهزيمة ممثلة في المشير الراحل عبد الحكيم عامر وكبار القادة العسكريين، فإنهم كانوا يتطلعون إلى تصحيح الرئيس الراحل لما وقع من أخطاء أدت إلى احتلال شبه جزيرة سيناء، والذي اعتبروه مسئولاً عنه، والقيام بتحرير الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب يونيو 1967، ولذا جاءت وفاته المفاجئة لتضع البلاد في حالة من عدم التيقن حول المستقبل ودخول الكثير من المواطنين، خاصة من الشباب، في حالة من الإحساس بالضياع وعدم معرفة مصير مصر ومن سيقودها بعد وفاة الرئيس الراحل عبد الناصر وكيف سيقودها.
أما السبب الثالث لصدمة بعض المصريين من جراء وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فكانت تتعلق بأولئك الذين بنوا مساراتهم الوظيفية والحياتية وربطوا مصائرهم العملية والشخصية والعائلية بالنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي وضع معالمه الرئيس الراحل والنخبة السياسية المحيطة به على مدار سنوات حكمه الستة عشر ما بين عامي 1954 و1970، وحتى بعد الانتكاسات التي تعرض لها ذلك النظام، مثل انفصال سوريا عن دولة الوحدة مع مصر في سبتمبر 1961 بعد ثلاث سنوات وسبعة أشهر من قيامها، وهزيمة 5 يونيو 1967 العسكرية، فقد بقي هؤلاء يشعرون بالأمان على وظائفهم وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية حيث كانوا يعلقون ذلك على بقاء الرئيس الراحل جمال عبد الناصر شخصياً في موقعه الرئاسي، وبالتالي جاءت وفاة الرئيس الراحل المفاجئة لتجعلهم يشعرون بدورهم بغياب الأمان على وظائفهم وعدم معرفتهم بالتوجهات الجديدة لرئيس الجمهورية الجديد آنذاك الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
وقد تميز الأديب والروائي والقصاص الكبير والأستاذ الجامعي البارز الدكتور عمرو شعراوي في روايته "أسفار النسيان" وأجاد في عرض تلك النوعيات المختلفة من الشخصيات التي ذكرناها فيما سبق، وغيرها، بشكل غاص داخل كل منها، سواء من جهة السعي لقراءة التركيبة النفسية والذهنية أو تناول وتحليل المصالح المتعلقة بالحالة الاقتصادية والمكانة الاجتماعية لكل منها، وبالتالي، وفي السياق الروائي، بلور الكاتب تطور تفاعل تلك الشخصيات فيما بينها وبينها وبين الأحداث المحيطة وتطوراتها، وذلك بحسب ردود فعل تلك الشخصيات ومدى تأثرها بوفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
أما عام 1971، فقد حفل بأكثر من حدث انعكسوا جميعاً في رواية الكاتب والروائي الكبير الأستاذ الدكتور عمرو شعراوي.
أما الحدث الأول فكان صراع السلطة الذي جرى بين الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات ورموز الدولة المصرية في المرحلة الناصرية، والذي جرى في شهر مايو من عام 1971، والذي انتصر فيها الرئيس الراحل السادات ووضع خصومه السياسيين في السجن بعد محاكمات كانت، مثلها في ذلك مثل بقية المحاكمات في القضايا السياسية التي جرت منذ ثورة 23 يوليو 1952، أقرب للمحاكمات السياسية منها إلى المحاكمات القضائية. ومرة أخرى، كانت ردود أفعال المصريين متنوعة وتختلف فيما بينها تجاه أحداث مايو 1971، بين من رآها "انقلاباً" على ثورة 23 يوليو، أي ثورة مضادة، كما وصفها الخصوم السياسيون للرئيس الراحل السادات، بينما هناك من رآها "ثورة تصحيح" أو "حركة تصحيحية"، حسب ما أطلق عليها الرئيس الراحل السادات وأنصاره، وهناك من اعتبرها مجرد صراع سلطة بين طرفين طامحين للسيطرة على السلطة.
إلا أن الرواية تبرز أيضاً بين طياتها ردود فعل أكثر عمقاً من جانب بعض شخصيات الرواية في تفسيرها لأحداث مايو 1971. فالبعض قرأ تلك الأحداث باعتبار أن نتائجها سوف تؤدي إلى تحولات في سياسات مصر الداخلية والخارجية تجاه ليبرالية اقتصادية وانفتاح سياسي محدود وتقارب مع التيارات الدينية التقليدية وابتعاد لاحق عن الاتحاد السوفيتي مقابل تقارب مع البلدان الغربية بدايةً بأوروبا الغربية ثم الولايات المتحدة الأمريكية ثم تم تتويج كل ذلك عبر التوجه نحو نهج تسوية سلمية للصراع مع إسرائيل. وعلى جانب آخر هناك من شخصيات الرواية التي بين أيدينا من اعتبر أحداث مايو 1971 بمثابة إيذاناً بصعوبة خوض مصر تحت قيادة الرئيس الراحل أنور السادات لحرب ضد إسرائيل أو صعوبة تحقيق اختراق نوعي في مثل تلك الحرب في حالة خوضها.
وكان الحدث الثاني الذي جرى في عام 1971، والذي عكسته رواية "أسفار النسيان" للروائي الكبير الأستاذ الدكتور عمرو شعراوي في تطورات أحداثها، هو تعهد الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات بأن يكون عام 1971 هو "عام الحسم" فيما يتعلق بالتوجه نحو مواجهة عسكرية مع إسرائيل، وهو تعهد أثار بعض روح التفاؤل لدي بعض المصريين، بينما شكك فيه الكثير من المصريين آنذاك، باعتبار أن الرئيس الراحل السادات قد طرح في بدايات العام نفسه، 1971، ما اسماه بمبادرة سلمية باقتراح انسحاب إسرائيل داخل شبه جزيرة سيناء مقابل إعادة فتح قناة السويس للملاحة الدولية، وهو مقترح لم ينجح الرئيس الراحل السادات في الحصول على دعم أو تحمس له من جانب الولايات المتحدة الأمريكية كما لم تقبل به إسرائيل آنذاك، وبالتالي اعتبر أصحاب هذا الرأي أن الرئيس الراحل السادات لم يكن جدياً في حديثه عن "عام الحسم".
وكان الحدث الثالث الهام والذي جرى في عام 1971، وجاء في سبتمبر من ذلك العام، وهو إعلان قيام اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة بين مصر وسوريا وليبيا، وهو مرة أخرى حدث بدا عصياً على الفهم في عيون الكثير من المصريين كما عكست أحداث رواية "أسفار النسيان"، فالبعض اعتبره ربما قد يكون تمهيداً للتنسيق العسكري بين مصر وسوريا للتحضير لحرب عربية مشتركة ضد إسرائيل، بينما الكثيرون تعجبوا من ذلك التطور باعتبار أن توجهات الرئيس الراحل أنور السادات قد بدأت بوادرها تظهر وتوضح أنه لم يكن متحمساً للبقاء في خندق واحد مع "الجمهوريات" العربية وله توجهات أكثر قرباً من "الملكيات" العربية.
وبالمقابل، فقد كان الحدث الأهم بلا شك والأكثر تأثيراً في المجتمع المصري في عام 1972، وحظي بمساحة هامة من التغطية في رواية الأستاذ الدكتور عمرو شعراوي وفي التفاعل فيما بين شخصياتها وفي التأثير على مسار تطورات أحداثها هو المظاهرات الطلابية، والتي امتدت إلى قطاعات شعبية أخرى في صفوف المجتمع المصري، والتي جرت في عام 1972، وهي مظاهرات لا يمكن بأي حال من الأحوال فصلها هن مظاهرات 1968، بالرغم من أن مظاهرات 1968 كانت موجهة ضد سياسات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بينما كانت مظاهرات 1972 كانت موجهة ضد سياسات الرئيس الراحل أنور السادات، إلا أنه في الحالتين فقد تعلقت مطالب المظاهرات إلى حد كبير بتبني نفس المطالب تقريباً وهي المطالبة بسرعة القيام بحرب تحرير لاستعادة الأراضي المحتلة في حرب 5 يونيو 1967، والدعوة لتبني نهج حرب التحرير الشعبية لتحقيق هذا الهدف، والمطالبة بالديمقراطية السياسية وضمان الحريات واحترام حقوق الإنسان، والدعوة للحفاظ على المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية التي حققتها الطبقات الدنيا والوسطى في المجتمع المصري خلال الحقبة الناصرية بل والعمل على تعزيزها والتوسع فيها.
كما أنه في الحالتين، أي في عام 1968 وفي عام 1972، كانت القيادة للحراك هو لقوى اليسار، ولكن مرة أخرى لم يكن هو اليسار التقليدي القديم المعروف، بل هو يسار من نوع جديد يقوده ويمثله شباب وطلاب في مقتبل العمر. وكان الاختلاف الرئيسي بين الحراكين هو أنه في عام 1972 كان المحرك الرئيسي للتظاهر في بداية العام كان انتهاء عام 1971 بدون أي حسم عسكري في مواجهة إسرائيل، كما كان قد وعد الرئيس الراحل السادات في عام 1971، وهو الأمر الذي دفع بالرئيس السادات إلى إلقاء اللوم على عدم تلقي الدعم العسكري السوفيتي الذي كان يتطلع إليه وتبرير القادة السوفييت ذلك بانشغالهم في وتركيزهم على الحرب التي قامت بين الهند، حليفة الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت، وباكستان، حليفة الولايات المتحدة الامريكية آنذاك، وهي حرب نجحت الهند، بالدعم العسكري السوفيتي، في حسمها لصالحها.
ولذا فقد لجأ الرئيس الراحل السادات إلى اتخاذ قرار طرد الخبراء العسكريين السوفييت الذين كانوا متواجدين في صفوف القوات المسلحة المصرية، وهو قرار اتخذه في مايو من عام 1972، ولكن استقبله الكثير من المصريين آنذاك بأنه دليل على عدم وجود لنية دخول مصر تحت قيادة الرئيس الراحل السادات الحرب مع إسرائيل لتحرير الأراضي التي تم احتلالها في حرب يونيو 1967، مما أشعل التظاهرات الشعبية من جديد، خاصة عندما بدأ الرئيس الراحل السادات في نفس العام، أي 1972، الحديث عن ما أسماه بـ "عام الضباب"، وذلك عقب القمة الأمريكية السوفيتية بين الرئيس الأمريكي آنذاك الرئيس الراحل ريتشارد نيكسون وسكرتير عام الحزب الشيوعي السوفيتي في ذلك الوقت الراحل ليونيد بريجنيف، وما صدر عنها مما سمي أحياناً بسياسة الوفاق وأحيان أخرى بسياسة الانفراج بين القوتين الأعظم في العالم في ذلك الوقت، والذي تضمن، ضمن أمور أخرى، التعهد بالحفاظ على الوضع القائم في الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي مثل ضربة للقيادة السياسية وللشعب في مصر المتطلعين إلى دعم سوفيتي فعال لبدء حرب التحرير.
وهكذا عرضنا في هذا المقال للسنوات الخمس الأولى ضمن العقد الذي تناوله الكاتب والأديب والروائي الكبير والأستاذ الجامعي المتميز الدكتور عمرو شعراوي في روايته المتميزة "أوراق النسيان" ما بين علمي 1967 و1977، وكيف عكست أحداثه الرواية وتأثير تلك الأحداث على المجتمع المصري وتفاعله معها كما يبرز الكاتب ببراعة عبر شخصيات روايته، وسوف نغطي في الجزء الثاني والأخير القادم من هذا المقال السنوات الخمسة المتبقية من ذلك العقد كما تناولته الرواية التي بين أيدينا حتى تكتمل الصورة للقارئ للتعرف على شمولية رؤية هذه الرواية المركبة والمبهرة من جهة الحبكة الروائية واللجوء للتحليل النفسي والاستعانة بمناهج التحليل الاجتماعي.