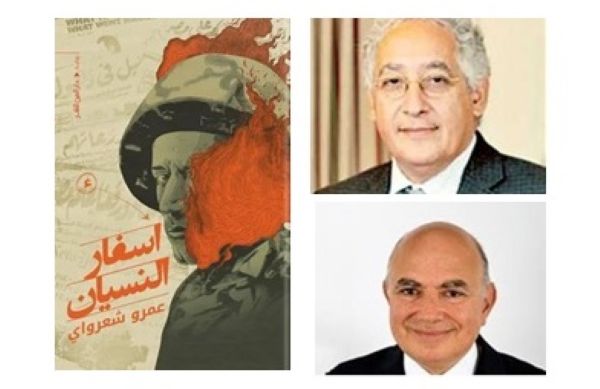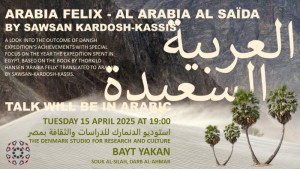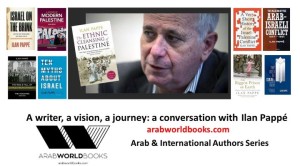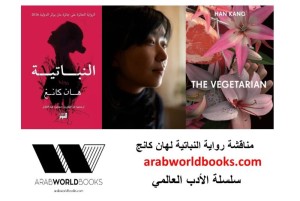في مقال سابق تشرفت أن نشرته مجلة "الدبلوماسي" الغراء في عددها لشهر مارس 2025، تناولت النصف الأول من الفترة الهامة من تاريخ مصر المعاصر التي تناولها الكاتب الكبير والروائي المتميز والأستاذ الجامعي الدكتور عمرو شعراوي في روايته الرائعة "أسفار النسيان"، أي ما بين 1967 و1977، التي نشرتها دار العين المصرية في عام 2022، وشرفت بعد نشر المقال السابق بتلقي تعليقات إيجابية من أساتذة وأصدقاء وزملاء وتلاميذ لي، حملت جميعها تقديراً وإشادة بالجزء الأول، وأعرب أصحابها الكرام عن تطلعهم لقراءة الجزء الثاني من المقال الذي وعدت به في مقالي الأول، وها أنا أوفي بالوعد، وأتعرض هنا في الجزء الثاني من مقالي التحليلي والنقدي حول هذه الرواية الهامة للنصف الثاني من الفترة التاريخية التي يغطيها المؤلف في روايته، حيث أن المقال السابق تناول الفترة ما بين 1967 و1972، بينما هذا المقال يتناول الفترة من 1973 إلى 1977.
وإذا بدأنا بعام 1973، فإنه كان نقطة تحول في حياة الشعب والمجتمع في مصر آنذاك، بل كان أيضاً نقطة تحول هامة في حياة بطل رواية "أسفار النسيان" للكاتب والأديب المتميز الدكتور عمرو شعراوي، كان من المفترض أن تقوده إلى الكثير من التفاؤل والتعامل الإيجابي مع الحياة ومع المجتمع من حوله، بدءًا بأسرته ومروراً بحبيبته وانتهاءًا بكافة دوائر التعامل الاجتماعي من حوله. وجاء ذلك كله في ضوء حرب أكتوبر 1973، التي كانت بمثابة شعاع الضوء واكسير الحياة للغالبية العظمى من الشعب المصري في ذلك الوقت، حيث بشرتهم بانطلاقة جديدة، ليس فقط على صعيد تحرير بقية الأراضي التي احتلت عام 1967، بل من منظور أشمل باعتبار أنها تمثل الفرصة لإعادة بناء المجتمع والدولة على أسس جديدة تكفل تطوير المكاسب الاجتماعية التي تحققت في الحقبة الناصرية، ولكنها تقود ايضاً إلى تحقيق تقدم على مسار الديمقراطية السياسية وتشكل فرصة تاريخية لإعادة تفعيل مسيرة التنمية الاقتصادية التي تعطلت بدرجة كبيرة بقعل هزيمة 1967 وتكريس غالبية الموارد والعوائد الوطنية لمهمة إعادة بناء القوات المسلحة.
وتعكس الرواية بصدق حالة النشوة والسعادة والفرح التي عاشها المصريون خلال وبعد حرب أكتوبر 1973، ولكنها ايضاً تعكس، وبنفس الدرجة من الإجادة الدرامية، كيف تباينت، وبسرعة لم تكن متوقعة آنذاك، ردود فعل وتوقعات وطموحات فئات مختلفة من الشعب المصري من حقبة ما بعد انتهاء الحرب، وكيف كان ذلك التباين أمراً طبيعياً ومتوقعاً من منظور التحليل الاجتماعي والسياسي لتاريخ مصر المنقضي منذ ثورة 23 يوليو 1952، وما أفرزته تلك الفترة من تركيبة وخريطة طبقية جديدة للمجتمع المصري، من حيث المصالح الاقتصادية والتحالفات الاجتماعية، ومن ثم التوجهات والتطلعات السياسية، بحيث صار المجتمع من الناحية العملية بعيداً جداً عن صيغة "تحالف قوى الشعب العاملة" التي من المفترض أنها حكمت المشهد الاجتماعي والاقتصادي المصري منذ ما سمي بقوانين يوليو الاشتراكية في يوليو 1961، ثم تبني "ميثاق العمل الوطني" في يونيو 1962 ثم تأسيس "الاتحاد الاشتراكي العربي" باعتباره التنظيم السياسي والشعبي الوحيد بعد ذلك مباشرة في العام ذاته، وهي صيغة كان قد راهن كثيرون أنها غير قابلة للتحقيق من الأصل على أرض الواقع بسبب عدم انسجام القوى الاجتماعية المشكلة لذلك التحالف، بل وأحياناً تنافرها، إن لم يكن تناقضها، بينما راهن آخرون على صلابة تلك الصيغة وقدرتها على الصمود في مواجهة تحديات عديدة واجهها الشعب المصري، أبرزها بالتأكيد هزيمة يونيو 1967.
وتكشف أحداث الرواية أيضاً والتفاعلات بين ابطالها وشخصياتها عن بدء كل فريق في المجتمع تفسير الحرب وأسباب اتخاذ قرار شنها وأسباب توقفها ونتائجها، وذلك مباشرة عقب انتهاء الحرب، بل حتى خلال مراحلها الأخيرة، وتحديداً منذ حدوث ما سمي بثغرة الدفرسوار، وجاءت تلك التفسيرات نتيجة منطقية لاختلاف المصالح والمآرب، فمن الصحيح أن الغالبية اجتمعت على ضرورة الحرب، ولكن كل طرف رأى الحرب وطبيعتها والدور الذي يجب أن تؤديه والنتائج التي يتعين أن تتمخض عنها من منظوره ومن زاوية رؤيته، ليس لمجرد انتماءات فكرية أو أحلام إنسانية، بل ايضاً، وربما كان هذا هو الأهم، كما تبرزه الرواية، للوصول إلى مصالح ملموسة على أرض الواقع.
فبطل الرواية الذي شارك في الحرب، ورفاق له في السلاح، وآخرون ممن بقوا يؤدون الخدمة العسكرية منذ ما بعد هزيمة 5 يونيو إلى حرب 6 أكتوبر، وكذلك أجيال اكبر أو أصغر سناً، رأت في الحرب إيذاناً بانتهاء حقبة وبدء حقبة أخرى ولكن في نفس المسار المتبع منذ يوليو 1952 في سياقه العام، وترتب على تلك القناعة أن توزيع عائد الحرب من الناحية الاقتصادية ( أي ارتفاع مستوى المعيشة وعودة عجلة الاقتصاد للدوران وما يترتب على ذلك من توافر وظائف جديدة وكثيرة لـ "أصحاب الياقات البيضاء") والاجتماعية (مواصلة، بل وربما تعزيز، تقديم الدعم المادي والعيني في صور وأشكال مختلفة، للشباب من خريجي الجامعات، وتعزيز مكانتهم في المجتمع شكلياً وفعلياُ) سيكون لمن شارك فيها أو كان له دور في دعم التحضير لها وعدم التشكيك في حدوثها في المقام الأول، بينما كان هناك على الطرف الآخر، وليس بالضرورة النقيض، من فسر وفهم أن توجهات القيادة الجديدة للبلاد ممثلة في الرئيس الراحل أنور السادات لن تعيد إنتاج مسارات الماضي، وأنها بمجرد انتهاء الحرب سوف تغلق مرحلة وتفتح أبواب مرحلة جديدة مختلفة نوعياً بدرجة كبيرة عن سابقاتها، وأن الفرص الأكبر في مجال "التمكين الاقتصادي" و"الحراك الاجتماعي" لن ترتبط بالضرورة بمن شاركوا في الحرب أو ساعدوا على حدوثها أو آمنوا بها وأيدوها، بل سوف تتاح لمن هم أثبتوا خلال الفترة ما بين 1967 و1973 أنهم قادرون على انتهاز وتصيد الفرص المتاحة لحل أزماتهم الاقتصادية الشخصية والعائلية دون النظر إلى أو الحديث عن مصالح مجتمعية جامعة، كما أن تلك الفرص سوف تتاح لمن فضل أن يهاجر من مصر في أعقاب هزيمة يونيو 1967، خاصة إلى بلدان عربية أكثر ثراءًا، وتمكن من تراكم مدخرات تمكنه من العودة لاحقاً للاستثمار في مصر وجني أرباح كبيرة، او من هؤلاء ممن هاجروا لدول غربية وتمكنوا من عقد علاقات قوية مع مؤسسات وكيانات اقتصادية بتلك الدول، تمكنهم من العودة لاحقاً لمصر وفتح فروع أو توكيلات ومكاتب تمثيل لتلك المؤسسات والكيانات، بما يحقق لهم الكثير من المكاسب أيضاً.
ولم تطل فترة التوقعات والترقب وإطلاق التكهنات بعد انتهاء الحرب واستئناف الحياة العادية في مجتمع ما بعد الحرب، فقد بدأت البوادر والإرهاصات لمنظومة ما بعد الحرب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، داخلياً وخارجية، إقليمياً ودولياً، تتضح رويداً رويداً في بدايات عام 1974 بدءًا بإعلان تبني الدولة لسياسة الانفتاح الاقتصادي في ابريل من هذا العام، بحيث تجسدت تلك التوجهات الجديدة في "ورقة أكتوبر" التي تم تبنيها في ذلك التوقيت، وتزامن معها على الجانب السياسي إطلاق تجربة إنشاء المنابر داخل الاتحاد الاشتراكي العربي، تمهيداً لتصفية صيغة التنظيم السياسي والشعبي الوحيد، وقوبل الأمران في البداية بترحيب، مطلق من جانب وبتحفظ وحذر من الجانب الآخر، باعتبار أحدهما تم الوعد أنه سوف يؤدي إلى تحقيق الرخاء الاقتصادي والآخر تم تصويره على أنه سيؤدي إلى الديمقراطية السياسية المفقودة، أو ما يسميها الكثير من المؤرخين لتاريخ مصر المعاصر بأنها "الفريضة الغائبة" في ثورة 23 يوليو 1952 وما أفرزته من صيغ متتالية للنظام السياسي في مراحلها المتعاقبة.
ومن جهة سياسة الانفتاح الاقتصادي وما أفرزته من تغيير ملحوظ في البنية الطبقية للمجتمع المصري، وبشكل خاص نشأة وتطور طبقة جديدة ومتزايدة الاتساع من الوكلاء والسماسرة والوسطاءـ أي الذين لا يقدمون أي قيمة مضافة للاقتصاد ولكنهم يسعون للربح السريع والمتضاعف بلا حدود، وهو ما يسمى في العلوم الاجتماعية بطبقة "الكومبرادور"، فقد نجحت رواية "أسفار النسيان" بدرجة كبيرة في تناول هذه التطورات وتأثيراتها على المجتمع المصري وعلى الثقافة الاجتماعية من خلال أحداث الرواية وتطوراتها ومن خلال شخوص أبطال الرواية والفاعلين فيها، سواء من قاموا بأدوار رئيسية أو ثانوية، واتسم ذلك التناول بصيغ مركبة عكست حقيقة الواقع المجتمعي المصري المعقد خلال تلك السنوات، وذلك من أكثر من جانب، أولها التداخل بين تلك الظاهرة وارتفاع قيمة رأس المال في عيون قطاعات متزايدة من المجتمع المصري آنذاك في مواجهة قيمة العمل، وثانيها ما أبرزته تطورات تلك المرحلة وما تلاها من حدوث علاقة عكسية بين التفوق في التعليم من جهة والقدرة على توفير دخول مالية كبيرة تكفي لمواكبة متطلبات الحياة والمعيشة المتزايدة بشكل مطرد في أعقاب إعلان سياسة الانفتاح الاقتصادي في الربع الأول من عام 1974 من جهة أخرى، وثالثها بروز اتجاه إلى ما يشبه التحالف بين الساعين لاحتلال موقع "الكومبرادور" في الداخل، ومعظمهم ممن بدأت تطلعاتهم في هذا المجال في أن تجد متنفساً لها في أعقاب هزيمة 5 يونيو 1967 في ظل انشغال الدولة بأولوية إعادة بناء القوات المسلحة من جهة وتراجع قبضة الدولة في بعض المجالات والأنشطة الاقتصادية خاصة في قطاعات التموين والتجارة الداخلية، وبين مصريين ممن خرجوا خارج البلاد في أعقاب يونيو 1967، سواء لدول عربية أو غربية، ونجحوا في تكوين ثروات، وبعضهم إما أراد العودة والاستقرار في مصر في ظل تطورات الأوضاع بها في العهد الجديد أو رغب في مد نشاطه ليشمل مصر ضمن البلد الذي يقيم به وبلدان أخرى.
وعلى صعيد تجربة البدء في عملية تعددية سياسية مقيدة ومحكومة، والتي تزامنت تقريباً مع تبني خيار الانفتاح الاقتصادي، والتي تمثلت في إعلان إنشاء المنابر داخل التنظيم السياسي والشعبي الوحيد القائم آنذاك، وهو الاتحاد الاشتراكي العربي، ثم التراجع عن ذلك التوجه المطلق وقصر الأمر على ثلاثة منابر فقط: "يمين، يسار ووسط"، وبعد ذلك بشهور عديدة تم إعلان تحويل "المنابر" الثلاثة إلى "تنظيمات"، وتلى ذلك إجراء انتخابات في عام 1976، بناءًا على صيغة التنظيمات الثلاثة، وصولاً في نوفمبر 1976 إلى إعلان الرئيس الراحل محمد أنور السادات تحويل التنظيمات إلى أحزاب، فقد تابعنا عبر صفحات الرواية ردود الفعل المختلفة من شخصيات الرواية، على تباين درجات وعيها العام والسياسي ومستويات ما تحصلت عليه من تعليم والفئات العمرية التي تنتمي إليها وطبيعة انتماءاتها الطبقية وانحيازاتها الاجتماعية والسياسية، إن وجدت، تجاه تلك التطورات السياسية والظلال التي ألقتها على المجتمع ككل، سواء المواطنين المسيسين أو غير المسيسين، وعلى أوجه الحياة المختلفة به. وقد تباينت ردود الأفعال ما بين حالات تفاؤل متقدمة لدي البعض، خاصة بعض الشباب، المتطلع إلى الحياة في ظل نظام ديمقراطي ليبرالي مفتوح ومكتمل الأبعاد، بينما كانت ردود أفعال البعض الآخر تتسم بالحذر، بل والتشكك في صدق نوايا الرئيس الراحل السادات من جراء اتخاذ مثل تلك الخطوة، وربط ذلك بأمرين أحدهما داخلي وهو التمهيد للتخفف، إن لم يكن التخلص التدريجي، من أعباء الدعم الاجتماعي للفئات الاجتماعية غير القادرة، والآخر خارجي وهو التحرك بعيداً نحو الفكاك نهائياً من التقارب مع الاتحاد السوفيتي السابق والكتلة السوفيتية آنذاك على الصعيد الدولي ومن التقارب مع ما كان يسمى أو يعتبر "دولاً عربية ثورية أو تقدمية" على الصعيد الإقليمي، إلا أن هناك اتجاهاً ثالثاً في ردود الفعل على التوجه نحو التعددية السياسية كان مفاده الاقتناع بأن كل تلك التطورات هي تغييرات في الشكل وليس في مضمون النظام السياسي، وبقيت مجموعة رابعة من ردود الأفعال تمثلت في عدم اهتمام البعض بتلك التطورات والتركيز على كيفية كسب لقمة العيش لتوفير احتياجات حياتية أساسية للشخص ولأسرته، وأخيراً مجموعة خامسة من ردود الفعل كان أصحابها أيضاً من غير المهتمين بما يجري في المشهد السياسي وكل ما كان يعنيهم هو كيفية استغلال سياسة الانفتاح الاقتصادي لتحقيق أقصى أرباح ممكنة لهم ولأسرهم وفي أقصر فترة زمنية ممكنة.
أما العام التالي، أي 1975، فقد شهد بدوره تحولات ملفتة في المجتمع المصري بفعل تطورات سياسية واقتصادية وقرارات، ثبت وتأكد فيما بعد أن تأثيرها استمر مع المجتمع المصري حتى اليوم.
فكان التطور الأول ذو الدلالة الذي نجده منعكساً بقوة، وبشكل عملي، في الرواية الرائعة للأديب والكاتب والأستاذ الجامعي الكبير الدكتور عمرو شعراوي، هو إعادة فتح قناة السويس أمام الملاحة الدولية في 5 يونيو من ذلك العام عبر احتفالات كبرى دعا الرئيس الراحل أنور السادات العديد من قادة الدول في المنطقة وعلى صعيد العالم لحضورها، وحضرها بالفعل بعضهم وأناب البعض الآخر كبار مسئوليهم لتمثيلهم والمشاركة فيها باسم بلدانهم. وكان لهذا الحدث الهام بالتأكيد أهميته الرمزية ذات الدلالة، فقد كان بلا شك مصدراً للفخار للمصريين باعتبار أن القناة، التي أغلقت عقب حرب يونيو 1967، قد تم إعادة فتحها إيذاناً بأن مصر حققت اختراقاً نوعياً في حرب أكتوبر 1973، كما أنه من جهة المكاسب والعوائد والمنافع الاقتصادية فقد وفر إعادة افتتاح قناة السويس أمام الملاحة الدولية مصدراً إضافياً هاماً للدخل القومي بالعملات الأجنبية، أو ما كان يسمى آنذاك بالعملات الصعبة للدلالة على مدى صعوبة حصول مخصر على تلك العملات ذات الأسعار الحرة في أسواق المال الدولية، وهو دخل كان الاقتصاد المصري آنذاك في حاجة ماسة إليه لأوجه صرف كثيرة ولا تنتهي، منها ما يتعلق بما كان مفترضاً من استثماره في عملية الإحلال والتجديد للمنشآت الصناعية التابعة للدولة، خاصة في مجال الصناعات الثقيلة والتي توقفت تقريباً أو على الأقل تراجعت بدرجات كبيرة عجلة التمويل لها من قبل الدولة منذ حرب يونيو 1967 بسبب تراجع الموارد المالية العامة وتوجيه ما توفر منها لأولوية إعادة بناء القوات المسلحة المصرية، بالإضافة إلى الحاجة للإنفاق المفترض آنذاك على استيراد السلع الرأسمالية والوسيطة لإعادة تشغيل المصانع، وكذلك تلبية احتياجات العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد أكثر من 70% من احتياجات الغذاء للشعب المصري كان يتم استيرداها من الخارج في تلك الفترة، وذلك فقط على سبيل المثال لا الحصر، حيث كانت هناك أوجه كثيرة للإنفاق تحتاج للعملات الأجنبية، منها استمرار تطوير القدرات القتالية للقوات المسلحة لإجبار إسرائيل على الالتزام بما يتم الاتفاق عليه مع مصر في السياق الأوسع لما بات يسمى منذ ذلك الوقت المبكر بـ "عملية السلام" في الشرق الأوسط، خاصة في ظل التدهور المتواصل الذي شهدت العلاقات المصرية السوفيتية في عهد الرئيس الراحل أنور السادات والذي أدى بدءًا من عام 1975 إلى التحول عن التسليح من الاتحاد السوفيتي إلى التسليح من دول متنوعة مثل الصين الشعبية وكوريا الديمقراطية الشعبية (الجنوبية) وفرنسا، وتواصل وتصاعد التسليح من دول غربية بما استلزم توفير النقد الأجنبي.
إلا أن إعادة فتح قناة السويس أمام الملاحة الدولية كان له تابع داخلي اقتصادي لا يمكن إغفاله لتأثيره على المجتمع المصري بأسره وأنماط الاستهلاك به بشكل عام، ألا وهو قرار الرئيس الراحل السادات بإعلان مدينة بورسعيد "مدينة حرة"، بمعنى الإعفاء من الجمارك للأغراض الاستثمارية، ولئن كان هذا القرار ربما كان دافعه جذب وتشجيع الاستثمار الخاص المصري والعربي والأجنبي بغرض بناء مصانع والتصدير منها للخارج لجلب المزيد من موارد النقد الأجنبي، إلا أن الواقع على الأرض جاء مختلفاً، بل يمكن القول بأنه إلى درجة كبيرة كان مغايراً للمأمول أو المخطط أو المعلن من هذا القرار، فقد تحولت مدينة بورسعيد إلى مركز للاستيراد من الخارج، استغلالاً للإعفاءات الجمركية، ولكن للسلع الاستهلاكية الجاهزة مكتملة التصنيع القادمة من مختلف بلدان العالم، وصارت مقصداً لتجار ومستوردين قادمين من مختلف ارجاء مصر الذين إما جعلوها المركز الرئيسي لتجارتهم أو المنفذ لاستيراد البضائع ثم القيام بتهريبها إلى مدنهم الأصلية للاتجار بالسلع وتحقيق مكاسب مضاعفة بعد التمكن من التهرب من الجمارك، وذلك بالطبع بالإضافة إلى بعض أبناء بورسعيد ذاتها الذين إما كانوا تجاراً أصلاً أو تحولوا من أنشطة أخرى إلى النشاط التجاري، وبشكل أكثر تحديداً الاستيراد للسلع الاستهلاكية والكمالية، وسرعان ما تبخر الحلم لدي الكثيرين، ومنهم شخصيات في رواية "أسفار النسيان" للروائي القدير والكاتب المتميز الدكتور عمرو شعراوي، وبدلاً من أن تكون "المدينة الحرة" في بورسعيد مركزاً للنهوض بالصناعة الوطنية وللتصدير وجلب العملات الأجنبية، أصبحت عبئاً على الاقتصاد الوطني بل ومصدراً لاستنزاف ما هو موجود، ومحدود، لدي مصر من النقد الأجنبي، لاستيراد سلع استهلاكية وكمالية، وعلى الصعيد الاجتماعي ساهم النمط الجديد السائد في مدينة بورسعيد في إطلاق العنان لنمط استهلاكي شره بلا سقف وبلا حدود، وساهم في إحداث تغييرات سلبية في سلوك قطاعات من المجتمع المصري، مثل التفنن في التهرب من جمارك بورسعيد وفي كيفية تهريب سلع المفترض أنها تباع فقط داخل المدينة إلى خارجها وبيعها بأسعار مضاعفة في مدن مصر الأخرى، خاصة الرئيسية منها مثل القاهرة والإسكندرية، وتحول ذلك كله إلى "شطارة" و"فهلوة" وفضيلة، أي إلى قيم إيجابية يتم التشجيع على وجودها وانتشارها في المجتمع، ومما زاد الطين بلة، أن تلك التحولات جرت في مدينة بورسعيد، وهي ذات المدينة التي أطلق عليها، ولا يزال، لقب "المدينة الباسلة"، منذ أدت المقاومة الشعبية بها إلى لعب دور كبير في دحض العدوان الثلاثي البريطاني الفرنسي الإسرائيلي على مصر في عام 1956 ، ثم انقلب الحال بسبب سوء إدارة مسألة تحويلها إلى "مدينة حرة"، فصارت نموذجاً لحالة منفلتة من التهرب من الجمارك وللتحايل لاستنزاف المخزون الوطني من العملات الصعبة في استيراد سلع كمالية واستهلاكية وفي نشر نمط استهلاكي ترفي لا يليق بمجتمع كان خارجاً لتوه من الحرب ويسعى لإعادة بناء اقتصاده الوطني على أسس متينة ومستدامة، وكل ذلك مع عدم تحقيق فوائد ملموسة لغالبية أبناء المدينة، فلم تبن المصانع التي كان من المأمول أن توفر فرص عمل لأبناء المدينة، ولا تحقق تطور في التخطيط والتحديث العمراني لإعادة بناء المدينة بعد ما عانت منه، مثلها مثل مدن منطقة القناة الأخرى، خلال الفترة الممتدة ما بين حربي 1967 و1973. وهناك شخصيات أخرى في رواية "أسفار النسيان"، سعت للاستفادة، بأقصى درجة ممكنة، من هذه الحالة الجديدة، للعمل في الاستيراد، أو تحت غطاء "التجارة" العمل في التهريب من بورسعيد وتحقيق أرباح طائلة وسريعة وبلا عناء أو عمل أو جهد، عززت القوة الاقتصادية، ومن ثم المكانة الاجتماعية، لتلك الشخصيات في المجتمع حيث بدا أن الكلمة العليا صارت لمن يملك الثروة وليس لمن يحلم باستكمال تحقيق أهداف الثورة.
أما التطور الثاني الملفت في نفس العام، أي 1975، والذي جاء على الصعيد السياسي هذه المرة، وليس الاقتصادي، وتحديداً على صعيد المواجهة العربية الإسرائيلية، وتمثل في "اتفاقية فض الاشتباك الثانية" بين مصر وإسرائيل والتي تم التوصل إليها بعد جهود ووساطات أمريكية ومفاوضات مضنية، وتم التوقيع عليها في الأول من سبتمبر من عام 1975، وهي وإن كانت قد حققت الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الممرات في سيناء كما أعادت إلى مصر آبار بترول سيناء، وما ترتب على ذلك من توليد مصادر دخول إضافية لمصر من العملات الأجنبية آنذاك من وراء تحول مصر إلى دولة مصدرة للبترول، حتى ولو بكميات أقل من الدول النفطية العربية الأخرى، سواء في منطقة الخليج العربي أو في شمال أفريقيا، إلا أن ذلك تزامن مع نص في الاتفاقية المذكورة التزم فيه الطرفان، أي مصر وإسرائيل، باللجوء إلى تسوية أي خلافات بينهما في المستقبل بالطرق السلمية، وهو التزام ربما لم يلفت نظر الكثيرين من المواطنين المصريين العاديين الذين كانوا منهكين في البحث عن لقمة العيش لهم ولأسرهم كما كانوا يشعرون بثقل عبء الحروب المتتالية وما ألقته على عاتق بلادهم، وبالتالي على عاتقهم، من هموم، ولكنها بالتأكيد لفتت نظر الكثير من المسيسين والمثقفين والصحفيين والكتاب والإعلاميين وكذلك الناشطين في صفوف الحركات الطلابية والعمالية في مصر وقتذاك، خاصة من ذوي التوجهات اليسارية أو الناصرية، وبدأ هؤلاء في التحذير منه، مستفيدين من واقع التحرر النسبي على الصعيد الصحفي والإعلامي والسياسي في تلك السنوات.
كما أن هذا الالتزام كان محل هجوم صريح وواضح من العديد من الدول العربية الأخرى، خاصة تلك التي بدا الخلاف يدب او يتصاعد بين قادتها وبين الرئيس المصري الراحل أنور السادات بسبب التباعد في المواقف بشأن التعامل مع ملف الصراع العربي الإسرائيلي والموقف من الغرب ومن الاتحاد السوفيتي السابق، وكان منها سوريا، الشريكة مع مصر في حرب أكتوبر 1973، تحت قيادة الرئيس الراحل حافظ الأسد، وليبيا، تحت قيادة العقيد الراحل معمر القذافي، والجزائر، تحت قيادة الرئيس الراحل هواري بومدين، والعراق، تحت قيادة الرئيس الراحل أحمد حسن البكر، واليمن الديمقراطية الشعبية (الجنوبية) تحت قيادة الرئيس الراحل سالم ربيع علي، بالإضافة إلى بواكير الخلاف مع العديد من فصائل المقاومة الفلسطينية، خاصة اليسارية منها، والذي امتد بعد ذلك بعامين ليشمل الخلاف ثم الخصام مع حركة "فتح" ذاتها، كبرى الفصائل الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية ككل، وعلى الصعيد الدولي، سعى الاتحاد السوفيتي السابق إلى التركيز على هذا الالتزام لرمي القيادة السياسية المصرية آنذاك امام الشعوب والحكومات العربية الأخرى، خاصة الشعب الفلسطيني، بالتخلي عن التواجد ضمن المواجهة العربية الإسرائيلية وبالخروج عن وحدة الصف العربي إزاء القضية الفلسطينية، وبالتمهيد للدخول تحت عباءة النفوذ الأمريكي.
ونجد في شخوص ابطال الرواية، مرة أخرى، من لا يهتم كثيراً بتلك الاتفاقية أو دلالاتها، كما نجد من يراها تأكيداً لرؤيته السابقة على ذلك بسنوات لعمق التغييرات التي تبعد بمصر في المرحلة الساداتية عن مصر في المرحلة الناصرية، وكذلك نجد من يرى فيما ستؤدي إليه من تقارب بين مصر والدول الغربية فرصاً لأخذ توكيلات من شركات غربية أكثر او الكسب من الاستيراد من الغرب أو الدخول كسمسار في صفقات بين مصر ودول غربية، بغرض المزيد من التوسع في العمل التجاري وبالتالي المزيد من التربح، ونجد على الجانب الآخر ما بين صفوف الشباب، خاصة الطلاب في الجامعات والمدارس الثانوية أو الشباب حديثي التخرج، وكذلك فيمن قاتلوا في حرب الاستنزاف وفي حرب أكتوبر 1973، من يتوجس خيفة من تلك التوجهات ومن دلالاتها سواء بالنسبة للتوجهات المستقبلية للقيادة السياسية المصرية فيما يخص العلاقة مع العرب أو الموقف تجاه القضية الفلسطينية التي كان يرى هؤلاء ان مصر حاربت من أجلها خمس حروب كانت تقود فيهم الجبهة العربية. وبدأ هؤلاء منذ ذلك التوقيت يحاولون قراءة وفهم معالم المشروع الساداتي رباعي الأركان القائم على الجمع بين الانفتاح الاقتصادي والتحول نحو القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد، والسماح بتعددية سياسية محكومة ومقيدة وتتعرض عند الحاجة للتحجيم، والابتعاد عن الكتلة السوفيتية وحلفائها العرب والتوجه نحو التقارب مع الكتلة الغربية وحلفائها العرب، وأخيرا، وليس آخراً، التوجه نحو تبني خيار التسوية السلمية للصراع مع إسرائيل دون الحاجة ولو حتى بالتلويح باحتمالية الخيار العسكري.
وشهد عام 1976 التكريس المؤسسي للتوجهات التي تبلورت سريعاً، خاصة على مدار عامي 1974 و1975، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، فقد شهد إعادة انتخاب الرئيس الراحل أنور السادات لفترة ولاية رئاسية ثانية، كان من المفترض أن تكون الأخيرة طبقاً لدستور عام 1971، وإن تم تعديل الدستور في عام 1980 لينهي تقييد الرئاسة بفترتي ولايتين رئاسيتين فقط، كما شهد عام 1976 انتخابات نيابية لا زال الكثيرون يعتبرونها حتى الآن هي الأكثر نزاهة، نسبياً وليس بشكل مطلق، ضمن كافة الانتخابات النيابية التي جرت في عهدي الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر وأنور السادات، وتلا ذلك إعلان الرئيس الراحل السادات تحويل التنظيمات الثلاثة القائمة (اليمين والوسط واليسار) إلى أحزاب، بعد أن خاضت الانتخابات النيابية بالفعل بصيغة أقرب ما تكون للأحزاب، وحل الاتحاد الاشتراكي العربي والمؤسسات التابعة له وفي مقدمتها منظمة الشباب العربي الاشتراكي، وبالمقابل رفض الرئيس المصري تلبية طلبات بإنشاء أحزاب أخرى، كان من أهمها آنذاك عودة حزب الوفد وتأسيس حزب ناصري، وتحققت عودة حزب الوفد فقط عبر حكم قضائي في عام 1978، بينما استغرق الأمر عقدين من الزمان ليخرج الحزب الناصري إلى النور.
وعلى الصعيد الاقتصادي، تعززت سياسة الانفتاح الاقتصادي وصدرت العديد من القوانين التي تعزز حماية القطاع الخاص والاستثمار العربي والأجنبي، وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، أعلن الرئيس الراحل أنور السادات رسمياً في عام 1967 إلغاء معاهدة الصداقة المصرية السوفيتية الذي كان هو نفسه من وقعها بل وذكرت بعض الروايات أنه هو من سعى إلى التوصل إليها في عام 1971، وكان ذلك بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على أكثر من عقدين من العلاقات الوثيقة بين مصر والاتحاد السوفيتي السابق، ومثل دليلاً جديداً على عمق وحدة تحولات المرحلة الساداتية مقارنة بالمرحلة الناصرية.
وعلى الصعيد الخارجي أيضاً، بدا أن الجهود الدولية لإعادة انعقاد مؤتمر جنيف للسلام لتوفير ساحة متعددة أطراف للتفاوض بين العرب وإسرائيل قد باءت بالفشل لأسباب متنوعة، ومن ثم بدأت القيادة السياسية المصرية تفكر في طرق بديلة لحلة الوضع في مسار التسوية، خاصة مع حدوث تردي في الأوضاع الاقتصادية والحالة الاجتماعية الداخلية.
إلا أنه على صعيد السياسة الداخلية، استمرت للسنة السادسة على التوالي التظاهرات الطلابية خلال العام الجامعي احتجاجاً على سياسات الرئيس الراحل السادات الداخلية والخارجية، واستمر كل من اليسار والناصريين في قيادة تلك التظاهرات في ذلك العام، وهي التي جذبت تعاطف ومشاركة قطاعات أخرى من الشعب مثل العمال والموظفين وكذلك بعض قطاعات الطبقة الوسطى المناطق الحضرية، وخرجت المظاهرات في نوفمبر من ذلك العام خارج أسوار الجامعة والتحمت بحركة إضرابات واعتصامات لعمال النقل العام، وذلك فيما وصفه بعض الكتاب المؤيدين للرئيس الراحل السادات آنذاك بأنه ربما كان "البروفة" النهائية لانتفاضة 18 و19 يناير 1977 التي سنتناولها بعد قليل، وقد اعترض المتظاهرون في نوفمبر 1976 على غلاء المعيشة وعلى تحول سياسة الانفتاح الاقتصادي إلى مصدر لثراء البعض وليس لإنعاش الاقتصاد الوطني وتفعيله كما كان معلناً، كما طالبوا برفع كل القيود على إنشاء الأحزاب السياسية، وبعدم تخلي الدولة عن مسئولياتها الاجتماعية تجاه المواطنين، وعلى الصعيد الخارجي، أكد المتظاهرون على أولوية القضية الفلسطينية وضرورة مواجهة إسرائيل ورفض أي صلح منفرد معها، ونددوا بالتقارب المصري مع الولايات المتحدة الامريكية ودعوا للحفاظ على العلاقات الاستراتيجية مع الاتحاد السوفيتي السابق، ومرة أخرى تقفز بعض شخصيات رواية الأستاذ الدكتور عمرو شعراوي الممتعة والمحكمة "أسفار النسيان" لتروي مشاركاتها في أحداث ذلك العام، سواء في اتجاه أو في آخر.
أما عام 1977، والذي انتهت أحداث الرواية بتناول فعاليات وأحداث انتفاضة 18 و19 يناير 1977، حيث أن اشتراك بطل الرواية فيها شهد إصابته نتيجة تعرضه للضرب ومن ثم أصبح عاجزاً عن الاستمرار في الحياة كإنسان طبيعي، وبالتالي خرج من دائرة البشر الطبيعيين وبقيت له فقط أسرته الكبيرة لترعاه وتحميه، فقد كان هذا العام نقطة تحول مفصلية في تاريخ مصر المعاصر، وكنت أتمنى أن تمتد أحداث الرواية بعض الشيء لتشمل على الأقل عام 1977 بكامله نظراً لأهمية ذلك العام، فهو إن كان قد بدأ بانتفاضة يناير فقد شهد شهر يوليو من نفس العام أمرين شديدي الدلالة والخطورة، أولهما اختطاف ثم اغتيال العالم الأزهري الكبير الراحل فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسين الذهبي وزير الأوقاف الأسبق آنذاك على يد جماعة إسلامية متطرفة تتبنى الفكر التكفيري أطلقت على نفسها اسم "جماعة المسلمين" وأطلق عليها الإعلام اسم "جماعة التكفير والهجرة"، وثانيهما اشتباكات حدودية جرت على مدار أربعة أيام بين مصر وليبيا، عكست مدى تدهور العلاقات بين زعيمي البلدين آنذاك السادات والقذافي، ثم جاء شهر نوفمبر من نفس العام حدثاً ليشهد حدثاً مزلزلاً أوقع تغييراً نوعياً استراتيجياً في مسار الصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية، ألا وهو زيارة الرئيس الراحل أنور السادات للقدس فيما أطلق عليه "مبادرة السلام".
إلا أن ما تقدم لا يعني التقليل من أهمية ودلالات حدث انتفاضة يناير 1977 في حد ذاتها، وهي التي أطلق عليها الرئيس الراحل أنور السادات ومؤيدوه تعبير "انتفاضة حرامية"، بينما أطلق عليه خصومه من صفوف اليسار والناصريين وبعض الليبراليين تعبير "انتفاضة شعبية" وأطلقت عليها وسائل الإعلام الغربية تعبير "انتفاضة الخبز". وأياً كانت التسمية، فالثابت أن تلك الأحداث كانت من جهة علامة على أن السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومات المصرية المتعاقبة منذ تبني سياسة الانفتاح الاقتصادي في عام 1974 لم تؤد إلى تحسن في الأوضاع المعيشية للسواد الأعظم من المصريين بل أدت إلى معدلات تضخم غير مسبوقة لم تصاحبها أي زيادة حقيقة أو ملموسة في دخول من يعتمدون على العمل والرواتب الثابتة لكسب قوت يومهم هم وأسرهم، ومن ثم تدهور في الأوضاع المعيشية، ومن جهة أخرى، كانت تلك الأحداث أحد الأسباب الهامة التي دفعت الرئيس الراحل السادات للإسراع في البحث عن طرح جديد خارج الصندوق للسعي لإنهاء المواجهة العسكرية مع إسرائيل بشكل نهائي واستعادة الأراضي المصرية المحتلة عام 1967 والبحث عن إطار تفاوضي لتسوية القضية الفلسطينية ولإنهاء بقية الصراعات المسلحة بين دول عربية أخرى وبين إسرائيل التي تحتل أراضيها، وذلك بما ينهي حالة الحرب بين مصر وإسرائيل ويحقق حالة سلام نهائي تسمح لمصر بإعادة توجيه جزء من الموارد المخصصة للأغراض العسكرية إلى بناء الاقتصاد وكذلك الحصول على زيادة كبيرة في المساعدات الاقتصادية الغربية، خاصة الأمريكية، ومن المؤسسات التمويلية والاقتصادية الدولية التي للغرب اليد الطولى في عملية اتخاذ القرار بها في ذلك الوقت، ومن جهة ثالثة صارت تلك الأحداث هاجساً أمام الرئيس الراحل السادات، ومن بعده الرئيس الراحل مبارك، كل مرة تم العرض عليهما خلال فترات رئاستهما من قبل بعض مستشاريهم اتخاذ القرار بإنهاء الدعم عن السلع الأساسية للمواطنين، وهو الأمر الذي دفعهما إلى رفض اتحاذ مثل هذه القرارات بشكل قاطع.
وختاماً، أؤكد أن رواية "أسفار النسيان" للروائي المتميز والكاتب القدير والأستاذ الجامعي الكبير الدكتور عمرو شعراوي هي من أفضل ما كتب في المكتبة العربية في إطار أدبي، وبالمقارنة بالكثير من الروايات الأخرى التي كتبت عن نفس المرحلة، عن ذلك العقد الشديد الأهمية والدلالة في تاريخ مصر المعاصر (1967 – 1977)، في صياغة جمعت ما بين السرد الروائي الرفيع وإدماج بشكل منطقي لبعض أساليب التحليل النفسي، خاصة من منظور اجتماعي، والمساهمة في عملية التأريخ المجتمعي البعيد عن الروايات الرسمية والقريب من الروايات الأكثر واقعية وتأصيلاً وعلمية، بالإضافة إلى الاستفادة من مناهج التحليل السياسي، كل ذلك في سياق واحد متجانس وبلغة خطاب ومفردات سهلة ورصينة في آن واحد، وعبر معالجة اتسمت بالموضوعية والعمق والإبداع.
ولا شك أنني أنهي حديثي هنا بأن أوصي كافة القراء الكرام بقراءة هذه الرواية الهامة والمبهرة والممتعة في نفس الوقت.