دعني يا أبا صالح أبوح لك بسري. إنه سر الأسرار. لا يهمّني بعد كلّ هذا العمر ماذا ستقول عني. فأنا منذ عرفت نفسي قليل الاكتراث بما يردده هؤلاء الحمقى. عندما تصالحت مع نفسي اختلفت مع هذا العالم.
اعتدل في جلسته. وحرّك يديه للأعلى في محاولة يائسة لإصلاح غترته. وامتدت فترة صمت منقوشة على حافة العمر. نظر إلى أبي صالح. بينما نكّس الآخر رأسه نحو الأرض في خشوع العابدين.
أنا يا أبا صالح، لست إحسان الماضي. أكيد إنك فوجئت حين رأيتني، وقد أحنت هموم الحياة ظهري. وضيّعني الوطن والأبناء. لا أريد أن أقول إنني شبت قبل الأوان. بل لقد عشت سنيناً طوال. ولكن مالك وكل هذا الآن. دعني أحكي لك سرّي! أما لماذا أنت بالذات؟ فلأنك شاهد على تلك الأيام التي عشتها مع طفلتي الصغيرة! لا تظنّ إنني أقصد إحدى حفيداتي. لا. بل هكذا كنت أناديها يوماً ما. مازلت أتذكر تفاصيل تلك الأيام البعيدة. رغم مرضي. ورغم ذاكرتي المخترمة.
تململ أبو صالح في جلسته. شعر إن المكان غير مناسب لما سيقول إحسان. الرصيف الضيق. اشتداد الحرارة والرطوبة. جعلت منه قليل الصبر على سماع هذا الهذيان. كما إن أصوات السيارات العابرة، تشتت الانتباه وتعلو على صوت إحسان الضعيف. إلا إن إحسان عاود القول غير مكترثاً بكلّ تلك الضوضاء.
عرفتها في إحدى سفراتي البعيدة. صحيح إننا الآن في سنة ألفين وعشرين، وحدث ذلك في نهايات القرن الماضي! إلا إنك كنت معي في تلك السفرة يا أبا صالح. لا أدري هل تتذكّر أم لا! أم انك لا ترغب في التذكّر الآن. إنها ليلى. طفلتي الصغيرة. ذات الشعر الأسود. آه ما أجمل الليل الذي يشبه شعرها. وما أجمل عينيها الضاحكتين بوداعة القطط الصغيرة. هل تزوجت ليلى ثانية! هل لها الآن عدد كبير من الأبناء والأحفاد؟ ربما لم تعد تتذكّر إحسان الشامخ.
لو لم أزل شاباً، فاتناً، لأعدت أمجاد الماضي. إذن لذهبت إليها الآن، وأعدت كتابة تاريخ حياتي من جديد. ولما أضحيت حبيس هذا الرصيف الملتهب. في مواجهه الغبار، والرطوبة، وأصوات السيارات. صحيح إنني لم أعد شاباً، ولكن الأمنيات لم توجد إلا لرجل هرم مثلي. يشكو من كلّ علل الدنيا. رئتي فتّتتها السجائر. وذاكرتي دمّرتها هواجس زوجتي و ثرثرتها. فاعذرني على هلوستي.
يسعل بشدة. يختلط سعاله مع (مزامير) السيارة التي وقف بها شاب أمام المنزل. صاح الشاب بالعجوزين الجالسين على الرصيف، رافعاً صوته بالسلام. أما في داخل المنزل فقد كانت أصوات الأطفال وصراخهم، تتسرّب إلى الرصيف، والعظام كرطوبة الدمام. وعندما خرج ابنه خالد، قال بتأفف: ابتعد يا أبي عن مدخل المنزل قليلاً.
الآن يا أبا صالح أستطيع أن أقول بكلّ ثقة. إنني يومها كنت جباناً. لماذا لم آتي بها بعد أن بكت عند يدي. كم كانت جميلة تلك الطفلة الصغيرة. لم يبق الآن إلا ارتعاشة تلك اليدين لا من البرد بل من شيخوختي. إنهما تفضحان العمر أكثر من الشعر والوجه. هذه الرعشة التي لم يستطع الأطباء وقفها. لا أستطيع تخيّل وجه ليلى الآن بعد كلّ تلك السنون. فهي مازالت في ذهني فتاة في العشرين من عمرها. ولكني أستطيع أن أتحسس خدّي الذي التصق بعظام وجنَتَي الوجه. تلك التجاعيد المترهّلة لن تعجب ليلى الآن. هل تسمعني يا أبا صالح؟. أنا لا أتذكر التفاصيل رغم إحساسي بها طرية، ندية، كأزهار الربيع. أنا أعرف إن ليلى لن تعود، والزمن البعيد لن يرجع حاضراً… فلا تعتقد إنني جننت. بل إنها لحظات وفاء لزوجة غيّبتها المسافات البعيدة. والظروف الصعبة.
صمت إحسان الشامخ. فلم يبدأ أبو صالح بالحديث. احترم سكوته، ثم شردا بتفكيرهما بعيداً. وفجأة تعالت أصوات الأطفال من داخل المنزل. خرج ولديه محمد وعادل وزوجتيهما يساندون أمّهم، زوجته العجوز التي أقعدها المرض، للذهاب بها للمستشفى. لم يتحرّك، لم يثره المنظر. بل سأل نفسه ماذا تعمل ليلى الآن؟ بينما ركب الأربعة في السيارة المركونة بقرب الرصيف، وتحرّكت ببطىء متجهة شمالاً.
ماذا قلت لك اسمها… ليلى. لا إنها رجاء. لا تهمّ الأسماء الآن. فابنة الحسين الرحماني، أميرة متوَجّة. عيناها ضاحكتان دائماً. هدوءها. كلّ شئ فيها أنشودة سماوية، تتغلغل إلى الأعماق فتدميها. ولكن أتمنى إنها وجدت قلباً يحبها كما أحببتها. ويخاف عليها كما أخاف. صدّقني يا أبا صالح إن أمنيتي أن تكون قد عاشت سعيدة كما حلمتُ يوماً بإسعادها. ولكنّي جبنت من زوجتي هنا، أهلي. المهمّ إن رسائلها انقطعت أيضا منذ زمن طويل. لقد كتبت لي كلاماً جميلاً. وكتبت فيها كل قصائدي. حتى توقف ساعي البريد عن إيصال رسائلها دون سبب. هل ماتت؟ لا أظن ذلك. إنني أشعر رغم المسافات البعيدة، إنها تتنفس وتحيى… وإلا لما بقيت أمامك حياً. أنا لا أهذي. كما إنني لا أستطيع التوقّف عن التفكير فيها. تماماً كما لم أستطع أن أوقف حفيدي الصغيرين مهند وسمير من اللعب في حاجياتي الصغيرة. لو كنت قادراً على المشي والحركة… لسافرت إليها هناك. ولبحثت عنها طويلاً حتى أجدها.
تنتابه نوبة سعال حادة. يتوقف عن الكلام. يهمهم أبو صالح بشيء يشبه الاحتجاج. يرغب في القول: ألم تملّ من ذكرها؟ هل تذكرك هي الآن بعد كل تلك السنين الطويلة؟ أنا متأكد إن ليلى أميرتك المتوَجة، قد وطئت عتبات الشيخوخة الأولى. ولكنّه لم يقل شيئاً.
عندما أسمع الموسيقى أشعر بالألم واللوعة. تجتاحني ذكرى الليالي الصاخبة التي لن تعود. الليالي التي تفجّرها الموسيقى، والضحكات الرائعة. فأشعر بالحنين. عندما تركتها هناك يوماً ما. سافرت بعدها إلى جهات عدة. إلا إنني لم أستطع أن أذهب إليها. لم أجرؤ على زيارة بلادها البعيدة.
وأنا الآن مثل صقر عجوز، منتوف الريش، لا يقوى على الصيد أو الطيران. ولا يساوي في نظر صاحبه أكثر من ثمن حمار أجرب. دعني أجمع شتات ذاكرتي المتعبة. لا أدري ماذا ستقول ليلى عني بعد كلّ هذا الزمن الطويل. هل ستتذكرني. لا بد إنها تذكر إحسان، تذكر زوجاً، ورحاّلة. قد مرّ ببلادهم. فمكث أياماً ثم غادرها. هل فهمت ما أعني يا أبا صالح بسرّ الأسرار. لقد خلفت ولداً هناك. أتخيّله قد أصبح رجلاً الآن، يجري خلفه عدد من الصبيان الصغار. ألا تصدقني. رغم عجزي فأنا ذاهب إلى زوجتي وأبنائي.
هذه الهواجس التي ردّدها بلا ملل تؤلمه. شَدَّ غترته على رأسه. وقف بصعوبة. ثم مشى ببطىء، أحسّ بدوار خفيف. إلا إنه استند بيده على الجدار. نظر إليه أبو صالح نظرة تعجّب، واحترام، وحبّ. بينما راح إحسان الشامخ، يتعثّر في مشيته على الرصيف، حتى دخل المنزل.
هـواجس إحســان الشــامخ
By: Hasan Alshaikh - on: Saturday 18 November 2017 - Genre: Stories
Upcoming Events
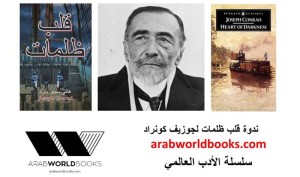
Joseph Conrad's Heart of Darkness Discussion
April 27, 2024
Join us for a special discussion of Joseph Conrad&...

A writer, a vision, a journey: a conversation with Francis Boyle
February 24, 2024
This event took place on 24 February 2024 Yo...

Discussion of Fawzia Assaad’s An Egyptian Woman
November 25, 2023
In celebration of the life and outstanding achieve...

Toni Morrison's The Bluest Eye, A Presentation and Discussion
October 28, 2023
This presentation and discussion of Toni Morrison&...
