حين عدتُ واسـتيقظتُ، وجدتُني ممدداً على كنبـة جـدي، منهكـاً ككـل مرة، وإن بدوتُ كمن استيقظ من نوم عميق. تعجزني شدة الإجهـاد عـن مجرد التقلُّـب على فراش الكنبة الطري. كنـتُ في نفس المكان عندما جاءوا، وكانت حجرة جدي خالية .. الكنبة تحت نافذة الحجرة مباشرة؛ وكانت النافذة مفتوحة، وخرجت جدتي، بعد أن ســوَّت فراش جدي، تشرف على عملية إعداد الإفطار. كنتُ مستلقياً على الكنبة، رافعاً سـاقيَّ، مستنداً بقدميَّ على إفريز النافذة العريض. كانت الشمس قوية تدفئ القدمين؛ وكنت هانئاً بالسكون، وفي ذهني أن مائدة الإفطـار قادمة، وأن ذلك يعني أنني سأسمع – بعد لحظات – صوت جدتي، في جرسه الموسيقي الجميل؛ تخصني أنا – من بين جميع الأحفـاد المتناثرين في البيت الكبير – وتناديني باسم التدليل الذي تقلب به صفتي إلى أنثى .. وكان في نيتي أن أتمهل، برغم إحساسي الشديد بالجوع، وأتشاغل عنها بالتأمل في صفحة من الصحف التي يكومها جدي بنظام خاص في ركن من إفريز النافذة. اعتدتُ أن أتخابث، لتأتي هي إليَّ – في كل مرة – وتعنفني، وتدغدغني، وتبحث، من فوق ملابسي، عن شيئ بين فخذيَّ؛ وأنا أروغ منها، غير راغب في أن أبتعد عن يديها؛ ولكنها لا تلبث أن تعلن احتجاجها، فقد أجهدتها، والجميع ينتظرونني؛ ثم تدعوني بلطف أن أنشـط وأقوم، وتميل عليَّ، وتلمس شفتاها وجهي، فتقتحمني أمواج الإحساس بروعتها. ولكن، سرعان ما يتبدل العالم تماماً فور أن أخرج، في ذيلها، من الحجرة .. وجوه أخرى .. متعددة .. عابسة؛ وأياد متحفزة تقبض على الأرغفة الساخنة، وأعينها مركزة على صحاف الفول المدمس الموزعة بنظام خاص على سطح الطبلية.
لم أنهض إلى حفل الإفطار البغيض، ولم يلحظ أحد من الجمع غيابي. كأنهم على علم بما يجرى، وأصبحوا مسلمين به، بعد أن تكرر كثيرا. بدأ الأمرُ منذ كنت وليداً ملفوفاً في قطع أقمشة من بقايا أثواب جدي وجدتي وأبي وأمي .. جاءت بي جدتي من سرير أمي إلى كنبة في قاعة الجلوس، حيث كان عبد الحميد الحلاق مستعداً بالموسي المغموس في السبرتو، فلما أزاحت جدتي اللفائف وباعدت بين فخذيَّ، شهقت، ثم أخذت تكبِّـرُ، وزغردت، ورقصت حتى ظنها المحيطون بها جُنَّـت، فأخذت تتصايح معلنة : ختنته الملائكة .. ختنته الملائكة !. صلى جدي ركعتين حمداً وشكرا لله على ( الكرامة ) التي ظهرت على أول أحفاده؛ ونفح الحلاَّق الجنيهين قائلاً : لا تحزن يا حلاق البهائم .. أجرك كما هو .. كأنك قمت بالمهمة !. وسألوا أمي، ألم تشعر بشيئ يحدث لي ليلاً. قالت، تهيأ لي أنني تحسست مكان نومه فلم أجده، ولكني قلت لعله كان حلماً. وكانوا – هناك - يبثون في وعيي أن أحداً لن يتمكن من التثبت – يقيناً – من أنني غير موجود. لن يبرد مكان نومي ليلاً، وسوف تنزل عليهم ســتر تلهيهم عني، كأنني غبت في ذاكرتهم غياباً مؤقتاً، فإن استعادني الأهل كانوا كما لو أنهم لم يفتقدوني لحظة. أما أنا، فأعلم تماماً أنني أتغيب .. أتلاشى كالأثير، وكنت – في مراحل متأخرة – أحسبني أواجه ملك الموت الذي تقول حكايات جدتي أنه يزور الميت قبيل أخذ روحه؛ وكنت أخاف، فأمنوني فزال خوفي؛ ولكن تلك المرحلة التي تتغشاني ظلت تصحبها الرهبة، حتى أستقر بين أيديهم فتزول. وحين أعود، بعد دقائق – ربما – أو بعد ساعات، يكون ذهني خالياً من أي خبرة بما جرى؛ وأحياناً أكون مجهداً، كأنما خلاياي تنطبق جدرانها، ويتهاوى جسمي، وقد يصيبني برد، حتى في الأيام الحارة، فألجأ إلى دثار ثقيل؛ وأحياناً تكون رحلة العودة عسيرة، فأصرخ أطلب من يحدثني لأستعيد رباطة جأشي، فلا يسمعني أحد؛ وما أن تمر دقائق، حتى أعود إلى صفائي، وأفتح عيني، وأجدني قد صرت حديد البصر، أرى أشياء عجيبة، وأشياء مرعبة، ولا أجرؤ على البوح. كنت جريئا في الصغر؛ ويوم وقف جمال عبد الناصر في ميدان المنشية وقال أممنا القنال، بـتُّ حزينـاً، فبعد أن عدت من التلاشي في تلك الليلة، أخبرت جدي في صباح اليوم التالي أن عبد الناصر يمضي في طريق مسدود. نهرني مستاءً لتعرضي للزعيم، فامتنعت عن الإفضاء بما أرى .. وعندما رأيته يقضي نحبه بين فخذي عشيقته "أم محمود"، في شقتها فوق المقهى الذي يرتاده يومياً، حزنت، وبقيت أراقب زحف الأيام إلى ذلك الحدث.
أشعر الآن بشبع تام، ولكني لا أجد الانتفاخ المصاحب لوجبة فول الضحى؛ ثم إن الوقت قد ابتعد عن الضحى كثيراً؛ فالنافذة مغلقة، والحجرة شبه مظلمة، ومصباح الكيروسين ( نمرة 5 )، المعلَّق في مسمار على الحائط، ينثر قليلاً من الضوء، ويفسد هواءها. وسمعت المطر يدق خشب النافذة. وكنت بلا غطاء، ولا أشعر بالبرد. كنت أحس طاقة كامنة يشعها جسمي؛ كما أن الحجرة كانت دافئة. دفأتها جدتي – ككل ليلة – بإشعال موقد الكيروسين بعض الوقت، قبل أن يسبقها جدي إلى الفراش. لم أجرؤ على دخول هذه الحجرة، من قبل، بعد أن يصعد جدي إلى فراشه العالي .. سرير حديدي أسود، بشرائط من الدانتيللا تجري مع محيطه العلوي، ثم ملاءة نظيفة دائماً، محلاة بالورود الكبيرة دائما، تغطي الفراش وتتدلى لتخفي جسم السرير، فلا يظهر القفص الضخم الذي تحتفظ جدتي فيه بالخبز البيتي الجاف، مخزون الأسرة الذي أصبح لا يكاد يغطي استهلاك أسبوع، بعد أن أصبح يجري ويزحف في البيت أحفاد كثيرون.
خفت أن يظن جدي أنني أتلصص عليه في رقدته. لن يصدق عجزي وقلة حيلتي تجاه الكيفية التي جعلتني أبقى فوق كنبته طول هذا الوقت، من الضحى إلى ما بعد العشـاء، فينقلب إلى وحش، لا يجرؤ أحد على حمايتي من لسعات حزامه الجلدي العريض. الأفضل، إذن، أن أبقى كما أنا .. بلا حراك .. بل والأفضل ألاَّ أتنفس، حتى أسمع شخيره العالي يتصاعد، فأنســـلُّ من هذا المكان الذي لا أحبه إلاَّ حين يجمعني وجدتي، فقط.
كنا، خارج الحجرة، نسمع غطيطه يتصاعد بعد لحظات من دخوله الحجرة، ولكنه الليلة يتأخر. بل إنه يهمس. ليس هو فقط. إنها جدتي، تبادله الهمس. وهناك أيضاً ضحكات صغيرة مكتومة. شجعني ذلك أن أحرك رأسي قليلاً، لأوسِّـعَ مجال الرؤية. لم يسعفني الضوء الشاحب. كان الجسمان الضخمان يتحركان. فجأة، تأوه جدي. قالت جدتي : سلامتك يا عيوني !. كنت أعرف أن الروماتيزم متمكن من عضلات ظهره، منذ أن كان يتناوب العمل ليلاً في محطة مياه الضغط العالي، في مينـا البصـل، على ترعة المحمودية. وبعد أن نجح في الانتخابات، وصار رئيساً لنقابة عمال شركة المياه، حصل على عدة ترقيات، ونقل إلى الإدارة في شارع فؤاد، وأصبح يجلس على مكتب، ويشتري صحيفة الجمهورية في كل صباح، وأحرص معه على قص كوبونات مسابقتها وترتيبها، وإرسالها في الموعد المناسب؛ ولم يكن يفقد الأمل في أن الحظ سينادي عليه يوماً. كانت مشاركتي له هذا الشأن تسعدني، وكان هو يستبشر بي، وإن كنت – طول الوقت – على يقين من أن الحظ لن يطرق بابه.
وصلت إلى أنفي رائحة نفَّـاذة أعرفها : الكافور. لا بد أنها تدلك ظهره. وكان مستمراً في تأوهه، ولكن نبرة صوته أصبحت أقل خشونة، حتى صارت لينة تماماً، وخلته يوشك أن يدخل في النوم وتنطلق صفاراته. سمعت صوت جدتي : أحسن يا سيد ؟. زام، فقط. عادت تقول : نوم العوافي يا حبيبي !. همس بما لم أستطع تفسيره. لم تفلح في تكتيف ضحكة رفيعة، وسألت مداعبة : والروماتيزم يا أبو سعد ؟!. نهرها : مالك أنت يا لبؤة ؟! .. قلت لك هاتي العلبة !. قالت وهي تتحرك : آه منك .. آه!. ومدت يدها، فرفعت ذيل ملاءة السرير، ودست أصابعها بين المرتبتين، وعادت تستوي في مكانها. كان هو ينام إلى الداخل، ليحميها من رطوبة جدار الحجرة، وهي إلى الخارج، وكان لديَّ هاجس وخوف دائم من أن تسقط إلى الأرض وهي نائمة، ولكن ذلك لم يحدث أبداً. سمعت صوت العلبة الصفيحية تفتح. أعرف محتوياتها .. هلامٌ أسود، يشبه الدهان الذي كان يضعه عم عبد الحميد الحلاَّق على دماملنا لكي ( تنضج ) وتتفجر بالصديد. عثرت على تلك العلبة عدة مرات، وفي آخر مرة، ضبطتني جدتي أحاول أن ألمس محتوياتها بأصبعي. صرخـت فيَّ، ولم أرها منزعجة مثلما كانت وهي تهجم عليَّ، تضـرب يدي لتسقط العلبة على الأرض قبل أن ألمس محتوياتها غليظة القوام. وكانت لديَّ خبرة سابقة بهذه العلبة الدائرية الصغيرة، فقد كنت أصحب جدي، أحياناً، إلى المقهى ذي المراءات، عند كوبري راغب؛ وكان يتبادل العلبة مع عجوز غريب المظهر، فيعطيه الفارغة، ويأخذ أخرى ملآنة، بعد أن ينقده ثمنها. وكانا يتبادلان، أيضاً، حواراً مثل الذي يدور في أفلام محمود اسماعيل و المليجي وفريد شوقي ومحسن سرحان : البضاعة تمام ؟!.. تمام التمام يا معلمي ! .. صنف يصل لهدفه من أقرب طريق !. ويقهقهان، ويشاركهما بالضحك كل الجالسين .. حتى أنا، كنت أضحك معهم، فكان ضحكهم يتزايد.
خَتَـنَتْــهُ المـلائكـةُ
By: Ragab Saad - on: Friday 17 November 2017 - Genre: Stories
Upcoming Events
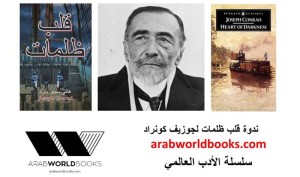
Joseph Conrad's Heart of Darkness Discussion
April 27, 2024
Join us for a special discussion of Joseph Conrad&...

A writer, a vision, a journey: a conversation with Francis Boyle
February 24, 2024
This event took place on 24 February 2024 Yo...

Discussion of Fawzia Assaad’s An Egyptian Woman
November 25, 2023
In celebration of the life and outstanding achieve...

Toni Morrison's The Bluest Eye, A Presentation and Discussion
October 28, 2023
This presentation and discussion of Toni Morrison&...
