المـــرأة فـي أدب نجيــب محفــــوظ مظاهر تطـوّر المـرأة فـي مصـــر المعاصـــرة من خـلال روايات نجيب محفـوظ : 1945 - 1967
وراء هذا الكتاب جهد وافر، قامت به مترجمة الكتاب، التي هي - بالوقت ذاته - مؤلفته. لقد وضعته المؤلفة/المترجمة بالفرنسية، فهو - بحقيقة الأمـــــــر - رســـــــالتها للدكتوراه، حصـــــلت بها على درجتهـــــا العلمية من جامعة ( جنيف )، بسويسرا، بالعام 1983. إذن، فقـد جــاء المؤلّـــــف الفرنسي ليحتـوي جهـدا أكـاديميـــا، توفرت له جوانب النجاح، بعد أن توفرت فيه متطلبات البحث العلمي الأكاديمي، من جدة، ودقة، ورصانة.
وتشير الدكتورة فوزية العشماوي، في تقديمها لترجمتها العربية لكتابها، إلى أن رسالتها - موضوع هذا الكتاب - كانت أول رسالة دكتوراه تناقش في جامعة أوربية، عن نجيب محفوظ، وأن الكتاب من الكتب الأوائل المبكرة، التي صدرت بالفرنسية عن محفوظ، قبل خمس سنوات من حصوله على جائزة نوبل، في العام 1988؛ ولكنها تمسك - تواضعـــا - عن أي إشارة إلى احتمال أن تكون دراستها العلمية الجادة والقيمة، وكتابها في طبعته الفرنسية، قد أسهما - بدرجة أو بأخرى - في تمهيد طريق نجيب محفوظ إلى نوبل؛ وإن كانت الدكتورة العشماوي تشير في مقدمة الكتاب إلى أنها، بحسها الأدبي، وبحكم تواجدها بالأوساط القريبة من مركز منح الجائزة، قد تنبأت لمحفوظ، في لقاء لهـــما بالعام 1979، بأنه سوف يحصل على تلك الجائزة رفيعة الشأن.
نحن - إذن - أمام كتاب ذي طبيعة خاصة، يندر أن تجد لحالته مثيلا؛ فقد ولد بهيئة بحث أكاديمي؛ ثم تحول إلى كتاب موجه للقارئ الأوربي؛ ثم رأت صاحبته ألاّ تحرم أبناء جلدتها من جهدها، فتوفرت على ترجمته للعربية؛ وهي ترجمة لم تكن سهلة، بالرغم من أن المترجمة هي ذاتها المؤلفة، وبالرغم من امتلاكهــا ناصية كل من اللغتين، إذ كان عليهـا أن تستغني عن التفاصيل التي لزمت للطبعة الفرنسية، لتعين القارئ الفرنسي على قراءة الكتاب .. مشوار كبير قطعه هذا الكتاب، لنقرأه ونحتفي به الآن؛ إذ استغرق الأمر ما يقرب من عشرين سنة ( 83 - 2002 )، ليصل هذا الكتاب ليد قارئ العربية.
وبالرغم من طول الرحلة، التي قطعهـا هذا الكتاب، إلاّ أنه لا يزال محتفظا بطزاجته، فلا يزال موضوعه مطروحا في الدوائر الفكرية والاجتماعية، حتى الآن؛ ولا يزال الجدل حول قضايا المرأة محتدما، غير محسوم؛ ولعل كتاب الدكتورة العشماوي، وهو يهتم بعرض مظاهر تطور المرأة في مصر المعاصرة، من خلال روايات نجيب محفوظ المنشورة في الفترة بين 1945 و 1967 .. لعله يساعد في إضاءة جوانب من هذه القضــايا، الخاصة بالشق المؤنث من أحد أنواع الكائنات الحية، أعطى لنفسه الحق في اعتلاء قمة هرم التطور بين سائر مخلوقات الله؛ ومع ذلك، لا يزال يعمّـق الفوارق بين شقيه، حتى أنه ليكاد يصنع منهما نوعين متباينين : أحدهما مذكر، وهو يري نفسه الأرقى، والآخر مؤنث، ويعيش - لا يزال - محروما من حقوق كثيرة يحتكرها الشق الآخر !
ويتكون الكتاب من تقديم، ثم مقدمة عامة؛ أما قلبه، فجزآن : الأول، نظرة عامة على مظاهر تطور المرأة في مصر المعاصرة، من خلال روايات نجيب محفوظ ( 1945 - 1967 )؛ والثاني، دراسة تحليلية موسعة لثلاث شخصيات نسائية؛ هي : " نفيسة " - بداية ونهاية، 1949؛ و " نـــور " - اللص والكــلاب، 1961؛ و " زهـــرة " - ميرامــار، 1967.
وتهتم المؤلفة، في مقدمة الكتاب، بالتأصيل للاهتمام بقضايا المرأة في مصر الحديثة، فتعود بالقارئ إلى مفتتح القرن 19، الذي شهد بداية حركة تحرير المرأة المصرية، واقتناع مجموعة من المثقفين والمستنيرين المصريين بأن تحرير الوطن يجب أن يبدأ بتحرير المرأة. كما تمهد المؤلفة لظهور نجيب محفوظ، فتشير إلى أن ذلك التطور في الفكر الاجتماعي قد صاحبه ازدهار في النشاط الصحافي والإنتاج الأدبي؛ وقد ترتب على ذلك الرواج الصحفي ارتفاع أسهم النثر العربي، على حساب الشعر. ولم يلبث ذلك النثر أن تخلص من عيوب كانت تجعله صعبا على قارئ الصحيفة؛ ثم ظهرت حركة ترجمة للروايات العالمية، التي أقبل عليها القراء؛ فأثمر ذلك كله أن بدأت إرهاصات الكتابات الروائية. ويسجل التاريخ الأدبي أن " زينب " – 1914، لمحمد حسين هيكل، هي أول رواية في الأدب العربي الحديث، يتوفر لها الشكل الأقرب إلى الاكتمال الفني. لقد تأثرت الموجة الأولى من الروائيين المصريين، والعرب عامة، بالحياة والأدب الأوربيين، بدرجات متفاوتة، حسب الخبرة الفردية بهذين العاملين؛ وقد صــوّرت المرأة في إنتاج هؤلاء الرواد الروائيين على أنها مجرد مخلوق جميل، يثير المشاعر، نبيلها أو خبيثها، على حد سواء، دون أن يكون لها كيان مستقل. كما أن معظم هؤلاء الأدباء قد تفادوا تقديم وتصوير المرأة المسلمة في رواياتهم، حتى لا يتعرضوا للتقاليد الإسلامية؛ ولجأوا إلى اختيار بطــلاتهــم من بنات وسيدات الأقليات. وحتى " زينـــب "، بطلة هيكل، لم يوفق المؤلف في إحكام رسم شخصيتها بحيث يقدم لنا بطلة مصرية حقيقية، عاشت في بداية القرن 20، فجعلهـا أشــبه بشــخصيات القرن التــــاسع عشـــــــــر التي صــــــورها ( جي دي موباســـــــــان ) في رواياته و ( لا مارتين ) في قصائده؛ إذ كانت زينب، الفلاحة ابسيطة، التي تنتمي للطبقة الكادحة، تتحدث برقة مفرطة، وبمفردات غريبة على لسانها الأصلي، عن الحب الذي يفضي إلى الموت عشــــقا !
وقد تباينت أنماط الشخصيات النسائية التي وردت في الروايات التالية لزينب؛ فمعظم من جاءوا بعد هيكل قدموا شخصيات نسائية، من الريف والمدن المصرية، ضعيفة وخاضعة تماما للرجل، يحميها أو يستغلها. أما ( العقاد )، فقد صور بطلته اليهودية " ســـــارة " - في الرواية التي تحمل اسمهـــا، 1938 - كامرأة مخادعة، كاذبة، خائنة؛ وعلى العكس منه، جاءت بطلات كتاب مثل محمد عبد الحليم عبد الله، ويوسف السباعي، نساء مثاليات، ملائكيـــات الطبـــاع.
ويهمنا، في هذا السياق، أن نشير إلى الفقرة الأخيرة من صفحة 22، التي تحتاج إلى مراجعة من المؤلفة، لأن صياغتها تصور للقارئ أن نجيب محفوظ جاء في جيل تال لمحمد عبد الحليم عبد الله ويوسف السباعي، ونعتقد أن ثلاثنهم من نفس الموجة.
كما نلاحظ، في هذا المجال، أن المؤلفة، في هذا الاستعراض التاريخي السريع، لم تشر إلى إحســـان عبد القدوس إلا في سطر واحد - صفحة 22 أيضا - بالرغم من أهمية هذا الروائي الكبير، الذي استأثرت الشخصيات النسائية بكل إنتاجه، وبالرغم من رؤيته الخاصة لقضايا المرأة، الأمر الذي كان من شأنه – بالمقارنة - أن يزيد من درجة تجسيد رؤية نجيب محفوظ الاجتماعية لهذه القضايا. وتنسحب هذه الملاحظة، أيضا، على روائي عملاق آخر، هو يوسف إدريس. ولعل المؤلفة تعود فتقدم لنا مؤلفا آخر يغطي هذه المنطقة، التي نتفهم أن عدم توقفها عندها ربما كان استجابة لحرصها على إحكــام تصميم وبناء بحثها الأكاديمي، ومن ثم كتابها، الذي استهدف - بالمقام الأول والأخير، وكما يقول عنوانه المحدد - الإنتاج الروائي لنجيب محفوظ وحده، وفي نصف مسيرته الإبداعية، التي امتدت لخمسين سنة، أطـــال الله عمره.
لقد كان ظهور نجيب محفوظ، في الأربعينيات من القرن العشرين، نقلة مؤثرة في تاريخ الرواية العربية، إذ استطاع هذا الكاتب العبقري - خلال النصف الثاني من هذا القرن العشرين - أن يخرج هذه الرواية من الإقليمية إلى آفاق العالمية، لأنه نجح في نقل الواقع الاجتماعي المصري، دون أن يقلد تيارا خارجيا، وإن كان استفاد كثيرا بالتقانيات البنائية للرواية. لقد جعل محفوظ من الرواية سجلا اجتماعيا لمصر الحديثة، إذ نقل - بصدق، وبدرجة عالية من الفن - واقع الوعي المصري المعاصر، وتفاصيل الحياة اليومية الاعتيادية في حواري وأزقة القاهرة المعزية.
وترصد المؤلفة البداية المبكرة لاهتمام نجيب محفوظ بقضايا المرأة، فتشير إلى مقالة كتبها الروائي العربي الكبير في مجلة ( السياسة الأسبوعية )، في العام 1930، وهو بعد في التاسعة عشرة من عمره، ويدعو فيها إلى ضرورة تعليم الفتاة، بينما ينتقد خروج المرأة للعمل في دواوين الحكومة، لأن ذلك يؤدي إلى انحلال الأخلاقيات في تلك الدواوين، ويزيد من حدة مشكلة بطالة الشباب، ويؤدي إلى تفكك الأسرة. والواضح أن الشاب نجيب محفوظ كان متأثرا في آرائه هذه بالفكر الاجتماعي المتحفظ الذي ساد تلك الفترة. كما تدلنا المؤلفة على مفتاح يجب وضعه في الاعتبار عند التعرض بالدراسة لإنتاج نجيب محفوظ، بعامة، يتمثل في ثلاثة تواريخ هامة، أثرت في محفوظ على نحو خاص، وفي الشعب المصري عامة، وهي : ثورة 1919، فمحفوظ هو ابن هذه الثورة، التي أرضعته أساسيات الوعي السياسي والاجتماعي؛ وثورة يوليو 1952، وهو من منتقدي هذه الثورة الأشداء؛ ثم هزيمة يونية 1967، وهي محطة أساسية، ارتاد بعدها نجيب محفوظ آفاقا روائية مختلفة، في مضامين رواياته وبنياتها، على السواء.
وكان من الطبيعي أن تتجاوز المؤلفة مرحلة الإنتاج التاريخي لمحفوظ ( رواياته الثلاث: عبث الأقدار – 1939؛ ورادوبيس – 1943؛ وكفاح طيبة – 1944 )، لأنها لا تخدم صلب قضية كتابها؛ وإن كانت توقفت أمامها، من الوجهة الفنية، إذ كانت هذه الروايات بمثابة حقل لتجريب ( الواقعية الحديثة )، التي اعتمد عليها محفوظ في كتاباته التالية، والتي خدمت نظرته الاجتماعية؛ إذ أن تلك الواقعية، كما أسس لها الناقد الألماني " باتريك أوبرباخ "، تهتم برصد وتصوير صعود تجمعات بشرية، ذات وضع اجتماعي متدن، إلى مستويات أعلى، بكل ما يصاحب هذا الصعود من مشاكل وجودية، وملابسات تخلقها تفاعلات هذه التجمعات في المجرى العام للتاريخ المعاصر.
وبعد فشل ثورة 1919، نجح محفوظ في نقل مشاكل الطبقة المتوسطة - وهو ينتمي إليها - من خلال شخصياته الروائية، التي انتقاها بعناية فائقة، ومنها الشخصيات النسائية؛ فاختار نساء عاديات من تلك الطبقة، يتوفر فيهن الصدق الفني، وكن مطابقات تماما للواقع الاجتماعي، وإن اختلفن من رواية لأخرى، حسب المهمة المطلوبة من كل شخصية على حدة، في خدمة البناء الروائي، ومدى نجاح الكاتب في استخدامها لتوصيل معلومات إلى القارئ، وتجسيد حقائق الأحداث والشخصيات الأخرى.
وكان بعض الشخصيات النسائية بمثابة المحور لمعظم روايات نجيب محفــــــوظ، مثل ( حميدة )، في " زقاق المدق "؛ و ( نفيسة )، في " بداية ونهاية "؛ وهما شخصيتان شاردتان، خرجتا عن التقاليد وانحرفتا.
وبدأ نجيب محفوظ، بعد يوليو 1952، مرحلة جديدة في مسيرته الروائية، وكانت مرحلة نقد مجتمع ما قبل الثورة قد انتهت بالثلاثية؛ ويقول محفوظ، في مقابلة صحفية : " بعد انهيار مجتمع ما قبل الثورة، لم يعد لديّ الرغبة في نقد ذلك المجتمع ". والواقع، أن التتابع السريع للأحداث أخذ الكاتب الكبير إلى أراض جديدة من الرؤى الفكرية والاجتماعية؛ وظهر ذلك في إنتاجه الجديد، الذي بدأ بروايته الشهيرة ( أولاد حارتنــا ) – 1959؛ وقد جاءت بعد سبع سنوات من تحسس واستكشاف ما جري في المجتمع، بعد الثورة. وقد أخرجت المؤلفة هذه الرواية من دائرة اهتمامها، عند إعدادها لهذا الكتاب، وذلك لأن لها طابعها الخاص؛ كما أن المرأة فيها لا تمثل نوعية المرأة المصرية، بل هي رمز عام للمرأة منذ بدء الخليقة؛ وإن كان محفوظ قد بدأ بهذه الرواية منهج النقد الاجتماعي، الذي تبدى بأوضح صوره في روايات المرحلة التالية : اللص والكلاب، 61 – السمان والخريف، 62 – الطريق، 64 – الشحاذ، 65 – ثرثرة فوق النيل، 66 – ميرامار، 67.
ويحسب للمؤلفة اهتمامها برصد التطور الفني في البناء الروائي عند نجيب محفوظ، وارتباطه بتطور الشخصيات النسائية، محور بحثها؛ إذ أن ذلك أعطي لهذا العمل قيمته كدراسة نقدية، ولم يقف به – كما في كتابات عديدة مماثلة عن نجيب محفوظ - عند حدود الرصد الاجتماعي؛ كما يحسب لها أنها لا تقدم لنا ملخصات لروايات محفوظ، لمجرد ملء فراغ الصفحات، كما يفعل كثير ممن يتعاطون الكتابة النقدية، ولكن استعانتها بالنصوص المحفوظية كانت تجيئ من خلال رؤى تحليلية لهذه النصوص، لخدمة غرض البحث.
وفي الجزء الثاني من الكتاب، المخصص للدراسة التفصيلية للشخصيات النسائية الثلاث : نفيسة، ونور، وزهرة، اتبعت المؤلفة منهجا أسمته ( تتبع المسار الروائي للشخصية )، وذلك من خلال :
= تحديد الإطار النفسي للشخصية.
= رسم المسار الحياتي لها.
= التوقف عند نهاية المسار الحياتي.
وقد استدعي هذا التتبع للمسار الروائي للشخصيات الثلاث التعرض للتكنيك وتطوره، فلم يعالج محفوظ الشخصيات الثلاث، كما أنه لم يكتب الروايات الثلاث ( بداية ونهاية – اللص والكلاب – ميرامار ) بطريقة واحدة.
وينتهي تحليل المؤلفة للمسار الروائي لنفيسة، بطلة ( بداية ونهاية )، إلى أنها أفضل نموذج روائي للمرأة المصرية، من الطبقة المتوسطة، يجسد حياة تلك الطبقة وأزمتها الاقتصادية الطاحنة، في فترة ما بين الحربين العظميين.
ويلفت نظر المؤلفة أن نجيب محفوظ شديد الاحتفاء بالنساء الخاطئات، ويقيم على بعضهن أبنيته الروائية، كمحاور رئيسية، أما النساء العاديات، مثل ( نوال )، في رواية "خان الخليلي" – 46، فهن لا يحظين باهتمام الكاتب، إذ أنهن مجرد إفراد متشابهات في قطيع، لا يصلحن لأن يقوم عليهن بناء روائي؛ أما إذا شردت واحدة من هذا القطيع، هنا ينجذب إليها الكاتب، أو الراعي، الذي يترك بقية القطيع، فهو مطمئن إليه، ويسعى خلف تلك الشاردة. وقد كانت ( نفيسة ) من الشاردات، وكذلك ( نور )، بطلة اللص والكلاب.
إن محفوظ، في احتفائه بالضالات الشاردات، يجتهد أن يجعل القارئ لرواياته يتعاطف معهن، ويتفهم ظروفهن التي دفعت بهن إلى الخطيئة؛ فالظروف القاسية، كما يقول الدكتور طه وادي في كتابه ( صورة المرأة في الرواية المعاصرة )، لا تجتث كل ما هو إنساني في الإنسان؛ بل يبقى دائما ذلك الهامش الإنساني، بمأمن من تلوث الجسد؛ وفي كثير من الحالات، تبقي الروح محتفظة بجوهرها، على درجة من النقاء. وهكذا، رسم نجيب محفوظ شخصية ( نور ) كامرأة ملوثة الجسد، نقية النفس، قلبها من ذهـــب !. ولكي يصل محفوظ إلى درجة الصدق الفني المطلوبة لكي يقنع قارئه بهذه الشخصية، تخلى عن منهجه الواقعي في بناء رواية اللص والكلاب، واعتمد على الرمز وتدفق الذكريات ( الفلاش باك )، فنجح – كما تقول المؤلفة - في أن يلف شخصية نور بدرجة من الغموض، وهو ما يتسق وشخصية المرأة البغي، في الواقع، إذ يهمها أن تتخفى وتتنكر، فلا ترصدها أعين المجتمع المتحفز لإدانتها !
وتفرد المؤلفة لشخصية ( زهرة ) مساحة أكبر من تلك التي أعطتها لكل من نفيسة ونور؛ ويسهل على القارئ أن يلمس انحياز الدكتورة فوزية العشماوي لزهرة واحتفاءها بها، بالضبط كاحتفاء نجيب محفوظ بهذه الشخصية الفريدة في أدبه. ويأتي تفردها من أنها أول فلاحة في الإنتاج الأدبي للكاتب الكبير، تتمحور حول شخصيتها رواية كاملة من رواياته، فهو لم يتعرض للريف في مجمل أعماله، وإن اعترف بأنه كان قد كتب رواية قديمة عنه، وأخفاها؛ وظل مخلصا للقاهرة المعزية، التي يعرفها حق المعرفة؛ وحتى عندما رسم شخصية نازحة من الريف، مثل زهرة، جعلها تعيش بعيدا عن مسرح رواياته الأثير، القاهرة القديمة، وأنزلها الإسكندرية، وهي مدينة يعشقها محفوظ، ولكنه لا يعرفها معرفته للقاهرة.
ومن خلال التتبع للمسار الروائي لزهرة، تؤكد المؤلفة على أن محفوظ يرمز بها إلى مصر. والحقيقة أن مصطلح ( الرمز ) لا يزال يكتنفه قدر من الغموض والقصور عند كثير من المبدعين والنقاد والقراء، على السواء؛ وقد كنا – في زمن مضى – نتسابق في البحث، مع النقاد، عن احتمال وجود رمز لمصر في أعمال روائيين ومسرحيين، من أمثال محفوظ ونعمان عاشور وسعد الدين وهبة، وغيرهم؛ وكان بعض الكتاب يتعمد، قسرا، أن يلصق صفة الرمز على بعض شخصيات هؤلاء، حتى تاه المعنى الحقيقي للرمز. فهل توفر معني الرمز في ميرامار ؟؛ وهل كانت زهرة – كما تقول الدكتورة العشماوي – رمزا حقيقيا لمصر، مكتملة أركانه الفنية ؟. هذا ما تؤكده المؤلفة في دراستها التحليلية والمتعمقة لشخصية زهرة؛ وأحسب أن هذه من أكبر الدراسات التي أفردت لشخصية واحدة في عمل أدبي، كتبت في الدراسات الأدبية العربية.
تقول الدكتورة فوزية العشماوي أن زهرة تستحق أن تكون رمزا لمصر، أولا، لأن نجيب محفوظ جعلها محورا لجميع الأحداث؛ وثانيا، لأنه رسمها ثائرة - - وقد ثارت عدة مرات … ضد من حاولوا استغلالها، بعد وفاة أبيها ( تماما، مثل مصر، بعد وفاة سعد زغلول، أبو الأمة المصرية، كما كان يوصف )؛ ثم إنها ثارت ثانية ضد من أرادوا الاستفادة من ورائها، من الأجانب ( ماريانا، اليونانية، مالكة نزل ميرامار )، والعجوز الإرستقراطي " طلبة مرزوق " ( تماما كمصر التي قامت بثورة يوليو 52 )؛ كما أن مجمل الخطوات التي خطتها زهرة في مسارها الروائي موازية لتلك التي خطتها مصر، بفضل ثورة يوليو.
ويهمنا أن نشير إلى أن المؤلفة أهملت التعرض للشكل الروائي الخاص، الذي اختاره محفوظ لرواية ميرامار، حيث جعل الرواية تحكى من وجهات نظر متعددة ومتباينة لشخصياتها، على مختلف مشاربهم واتجاهاتهم السياسية والفكرية والطبقية. فهـــــل أسهم هذا الشكل في اكتمال شخصية زهرة، وفي ترسيخ قيمتها الرمزية في الرواية ؟
وتنتهي الدراسة عند علامة تاريخية فارقة في تاريخ كل من الوطن، ونجيب محفوظ .. عند العام 1967؛ فبعد هذا التاريخ، بدأ محفوظ مرحلة، أو عدة مراحل، مختلفة تماما؛ وتمكن من شق طرق جديدة للرواية العربية؛ وارتفع حســـه النقــدي؛ وقد كان كل ذلك، فيما نحســــب، ضـــروريا، ومفيدا !.
المـــرأة فـي أدب نجيــب محفــــوظ
By: Ragab Saad - on: Wednesday 22 November 2017 - Genre: Book Reviews
Upcoming Events
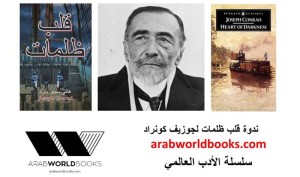
Joseph Conrad's Heart of Darkness Discussion
April 27, 2024
Join us for a special discussion of Joseph Conrad&...

A writer, a vision, a journey: a conversation with Francis Boyle
February 24, 2024
This event took place on 24 February 2024 Yo...

Discussion of Fawzia Assaad’s An Egyptian Woman
November 25, 2023
In celebration of the life and outstanding achieve...

Toni Morrison's The Bluest Eye, A Presentation and Discussion
October 28, 2023
This presentation and discussion of Toni Morrison&...
